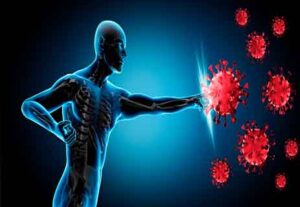ترك البشر في العصر الحالي واقعهم الحقيقي، وشرعوا في العيش داخل العالم الافتراضي. الجميع عيونهم ملتصقة في هواتفهم المحمولة، في أي حافلة أو سوبر ماركت أو مكان عمل أو المقاهي والمطاعم، يبدو أن الهاتف المحمول أصبح جزءاً من اليد، وماصاً لاهتمام الصغار والكبار. تقدم لنا الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية الأخرى المليئة بألعاب الفيديو أو الشبكات الاجتماعية أو الانترنت سيناريو يومي يختلف جذرياً عن أي جيل سابق: العالم الافتراضي الجديد.
الدخول إلى العالم الافتراضي
يتقدم رجلان عبر مدينة مدمرة بالكامل، إنهما على استعداد لفعل أي شيء للوصول إلى هدفهما. يقول أحدهما: هجوم العدو وشيك. فيسأله الآخر في فزع: في أي وقت، ومن أي زاوية. العيون شاخصة، واليدين تفوح منها رائحة العرق. حاول أن تغطي هذا الجانب، احذر عند دخول هذا المبنى، هكذا يتحدث أحدهما إلى الآخر. يسير الرجلان كتفاً بكتف. يبدو أنهما يعرفان بعضهما البعض جيداً. ويمكن لكل منهما أن يتعرف على نبرة صوت شريكه من خلال الأدرينالين الذي يثيره الترقب وعدم اليقين. لكن في الحقيقة لا يعرف أحدهما الآخر. وهذا المشهد بأكمله يدور في العالم الافتراضي، ويقوده طفل ممسكاً بهاتفه المحمول يجلس على مقعد في صالة المنزل.
على بعد أمتار قليلة يعكس زجاج الشاشة الأصغر الكثير من الفرح في عيون شابة جالسة على الأريكة. سبعة ” إعجابات” ورمز تعبيري لوجه مبتسم في عشر دقائق فقط. ويتشابك الصوت المتكرر لنغمة رنين الرسائل المتبادلة بين الشابة وأصدقائها مع صوت الطفل النشط الذي لا يتوقف عن إعطاء التعليمات من خلال الميكروفون لشريك المعركة.
تجلس سيدة ترتدي ملابس المنزل على الأريكة الأخرى، وهي تمسك بشاشة أكبر حجماً، وتضحك ملء فيها على ما يصدر من بطل المسلسل الكوميدي. في حين يظهر رجل في منتصف العمر وهو يتحدث عبر الفيديو مع شخص آخر عن آخر تطورات الصفقة. لا تزال الجدة التي تجلس في زاوية بعيدة تتأمل جميع أفراد العائلة وتنظر بعدم تصديق إلى اللوحات التي تكتسب كل يوم مكانة بارزة في المنزل.
تقول الجدة: “أخشى اليوم الذي تتجاوز فيه التكنولوجيا إنسانيتنا؛ العالم سوف يكون لديه جيل واحد فقط من الأغبياء”. ثم تستطرد في ألم “الزمن قد تغير” ليجيب عليها الطفل والفتاة بنظرة تحمل من الحيرة أكثر مما تحمله من الرفض.
| اقرأ أيضًا: ماذا يعني النجاح الحقيقي؟ |
قبل وبعد العالم الافتراضي

صنعت التكنولوجيا فجوة عظيمة في التاريخ. وتميزت بما قبل وما بعد، هذا بالنسبة لأجيال القرن الماضي الذين لازالوا ينظرون إلى الماضي بحنين مؤلم. فلم يتمكن هؤلاء من الوصول إلى مئات البرامج أو المسلسلات أو الأفلام. ولم يتمكنوا من الترفيه عن أنفسهم بأكثر ألعاب الفيديو تنوعاً وتعقيداً مثل تلك الموجودة في العصر الحالي. ولم يكن لدى الفرد منهم مليون صديق منتشرين في جميع أنحاء العالم يتبادلون معاً الإعجابات. ويخبروا بعضهم البعض عن أنشطة اليوم أو الاعتراف برغباتهم الأكثر حميمة.
كان العالم فيما مضى يقتصر على لعب “العسكر والحرامية” أو “الغميضة” أو “كرة القدم” أو “الحبل” أو أي لعبة أخرى يتخيلها هؤلاء بدافع الرغبة في الاستمتاع. أما الأصدقاء فكانوا يعدون على أصابع اليد الواحد. ولا يمكن التواصل معهم إلا وجهاً لوجه في العالم الواقعي الحقيقي. لقد ولدّت التكنولوجيا والعالم الافتراضي الجديد أمراضاً اجتماعية ونفسية لا حصر لها. لكن دعونا لا نجزم بهذا الأمر قبل أن نتعرف على تأثير التكنولوجيا على المجتمع.
| اقرأ أيضًا: الطريق إلى تحقيق الذات في الحياة |
تطور أم انقلاب
أجريت العديد من الدراسات على مر السنين حول تأثير التكنولوجيا على المجتمع. وتساءل العلماء والفلاسفة والمفكرين حول ما إذا كان هذا يقود البشر إلى تطور للأمام أم إلى ارتداد للخلف. تتفق معظم الدراسات التي أجريت حتى الآن على عدم وجود آثار سلبية على المستوى الفكري ناتجة عن ممارسة ألعاب الفيديو. وقد أشارت إلى أن لاعبي ألعاب الفيديو يتميزون بمستوى فكري أعلى من أقرانهم من غير اللاعبين، ويتمتعون باختلافات في أسلوب معالجة المعلومات في أدمغتهم. لكن لا ينبغي البحث عن علاقة سببية بين اللعبة وأعلى مستوى فكري. فإذا كانت هذه العلاقة موجودة، فمن المحتمل أن تكون العكس، بحيث يشعر الأفراد الأكثر موهبة فكرياً بفضول واهتمام أكبر بهذا الترفيه.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة أجراها باحث اقتصادي بجامعة ملبورن بأستراليا، وبعد أن حلل بيانات اختبارات أكثر من 12 ألف طالب استرالي يبلغ من العمر خمسة عشر عاماً في موضوعات مثل الرياضيات والقراءة والعلوم، خلص إلى أن الألعاب عبر الانترنت التي تشتمل على تحدي الشباب لحل الألغاز ثم الانتقال إلى المستويات التالية تساهم في زيادة المستوى الفكري لهم. لكن النتائج تتناقض مع نتائج الدراسة التي أجراها مركز دراسة العنف في جامعة ولاية آيوا، ووجد العلماء مؤشرات على أن ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تدفع الأطفال إلى رد فعل أكثر عدوانية وعنفاً. وكشفت هذه الدراسة أن أولئك الذين يمارسون ألعاب الفيديو العنيفة لساعات أطول في الأسبوع لديهم زيادات ميول إلى ردود الفعل العدوانية. إذن ليست كل الألعاب الالكترونية تساهم في زيادة المستوى الفكري للاعبيها.
هذه الألعاب الإلكترونية، كما يقول العديد من علماء النفس، تعتبر أكثر إدماناً من التلفاز نظراً لنظام المكافآت الخاص بها، وهيكل التكرار. وبالتالي فهي قادرة على خلق تبعية كبيرة لدى الأطفال والمراهقين. كما يؤكد آخرون أن حقيقة اللجوء إلى طريقة الترفيه هذه بشكل مستمر يمكن أن يسبب انخفاضاً في إنتاج مستويات الدوبامين، وهو هرمون وناقل عصبي يعزز مشاعر الشخصية الإيجابية والرفاهية.
| اقرأ أيضًا: العزلة الطواعية وتجربة العيش في الظلام |
سلاسل لا سبيل للخلاص منها

لا تتوقف هذه الخلافات بين الباحثين على الألعاب الإلكترونية فحسب، بل تمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام الانترنت بشكل عام. ففي أي مكان تقع أعيننا عليه نجد أن الهاتف المحمول أصبح امتداداً للجسم وجزء لا ينفصل تقريباً عن اليد، مما يجعل الجميع محاصر في هذا العالم الافتراضي. إن التطور لا يمكن إنكاره، ولكن بأي ثمن.
توفر لنا التكنولوجيا الجديدة وسائل اتصال وترفيه وتعليم رائعة، لا شك في ذلك. إن الإنترنت والأجهزة الإلكترونية على اختلافاتها، وألعاب الفيديو، والهواتف المحمولة، كل هذه الأمور وفرت لنا المعلومات الفورية وأصبح كل شيء في متناول اليد. والترفيه أو التفاعل الاجتماعي هو عامل جذب لهذه الأدوات التي من خلال سلسلت الجميع بسلاسل لا سبيل للخلاص منها. يكفي أن ننظر حولنا لنتأكد من أنهم ربطونا.
| اقرأ أيضًا: الجرائم الإلكترونية: التعريف والأنواع والأمثلة وطرق الحماية منها |
إدمان التكنولوجيا
إن الدليل الوحيد على وجود شخصين أو ثلاثة في غرفة هو تلك الأنفاس المتقطعة التي نسمعها بين الحين والآخر والتي تشير إلى أنهم على قيد الحياة. وعلى طاولة الطعام يكفي لنا استخدام يد واحدة للأكل واستخدام الأخرى في تقليب الصفحات على الشبكات الاجتماعية. حتى الحمام أصبح استديو تصوير جديد للعديد من المراهقين. فلقد أمسى التصوير هو السمة البارزة لهذا العصر. ويمكننا أن نختصر الصورة الكاملة للقرن الحادي والعشرين في أناس تتقدمهم شاشات الهواتف. ومع كل ذلك يقولون لنا لا يوجد إدمان، دون حتى أن يرفعوا أعينهم عن تلك المستطيلات.
هناك المزيد من الدراسات والاحصائيات التي تمحورت حول دراسة ظاهرة إدمان العالم الافتراضي، لكن لا يعترف بها المجتمع العلمي، لماذا؟ ربما بسبب المافيا الواسعة التي تتكسب من هذه التكنولوجيا، لكن ليس هذا موضوع مقالنا. لنعود مرة أخرى إلى الطبيعة البشرية وسبب التكالب على العالم الافتراضي وإدمانه.
يكمن إدمان هذه التكنولوجيا في الحاجة إلى الاعتراف، والقبول الشخصي، والاشباع السريع، وسهولة الاتصال بالآخرين بغض النظر عن المسافة المادية، وإخفاء الهوية الذي يسمح بإمكانية توصيل ما نريد وكيف نريد؟ إن فكرة الأنا هي الفكرة الرئيسية لكل هذه الأدوات وهو دافع عظيم لكسب الملايين من المتابعين دون مغادرة المنزل، وتلقي الإعجابات والإشادة من أشخاص لا تربطنا بهم أية علاقة.. إن تضخم الذات والشعور بأهمية زائفة لأنفسنا هي المحور الأساسي في إدمان التكنولوجيا.
| اقرأ أيضًا: هل تعاني المجتمعات الحالية من أزمة قيم؟ |
لقد تغير الزمن

إنها حقيقة. لقد تغير الزمن. ولى زمن قوائم الانتظار في أكشاك الهاتف الموجودة في أي حي من أجل الاتصال بقريب، ولى زمن انتظار وصول الرسائل المكتوبة بخط اليد لمعرفة أخبار الأصدقاء، ولى زمن اللعب في الشوارع والحارات. فمنذ أكثر من عقدين من الزمن، بدأت التكنولوجيا في دخول المنازل لتستقر أخيراً وتحدث ثورة في العالم. على الأقل تلك التكنولوجيا التي نربطها عادةً بالحداثة، على سبيل المثال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو ألعاب الفيديو أو الإنترنت أو الشبكات الاجتماعية، من بين أشياء أخرى كثيرة.
| اقرأ أيضًا: خصائص الأجيال الاجتماعية من الجيل الصامت إلى ما بعد الألفية |
التكنولوجيا لا يمكن إيقافها
اعتدنا على وجود هذه التكنولوجيا في حياتنا حتى إننا لم نفكر في المجهود العظيم وراءها. فهل ترى الكتب، أو الملابس أو المروحة البسيطة، إن هذه الأشياء موجودة دائماً في حياتنا ومع ذلك لم نفكر كيف نشأت. لقد نشأت هذه الأدوات التي سهلت حياتنا في مرحلة من التاريخ بفضل فضول بعض الناس وعملهم الجاد ومثابرتهم. باختصار، جاءت كل تلك التكنولوجيا التي أنتجها البشر عبر التاريخ بهدف وحيد هو تسهيل وتحسين نوعية الحياة.
ماذا سيكون شكل الحياة بدون أشخاص مثل جاليليو جاليلي، جوتنبرج، بليز باسكال، جراهام بيل، هيدي لامار، جريس هوبر أو ستيف جوبز؟ سمحت لنا سنوات حياتهم التي قضوها في البحث والدراسة والتجربة لنا اليوم بعقد اجتماع مع العائلة التي يعيش أفرادها على بعد آلاف الكيلومترات عبر تقنية الفيديو، أو إرسال رسالة تصل في أقل من دقيقة.
اختراع المطبعة في القرن الخامس عشر، والهاتف (1876)، والتلفزيون (1926)، وتطور الكمبيوتر الأول (1936) أو الإنترنت (1967)، كانت الأسس التي أدت إلى ظهور التكنولوجيا التي نتمتع بها اليوم. التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في العالم، ومنحتنا امتياز الفورية في وسائل الاتصال، أو الوصول إلى المعلومات، أو غزو وسائل الترفيه الجديدة. ولكن بعد ذلك، هل يجب أن نتخلى عن هذه التطورات؟
التكنولوجيا لا يمكن إيقافها. هذه الحقيقة ولّدت العديد من المعضلات وستستمر في توليدها: التلاعب والتبعية والإدمان والتحكم والسيطرة؟ كل هذه حقائق لا يمكن إنكارها. ولكن أين قدرتنا على الاختيار. يقول أينشتاين “يجب أن تسود الروح على التكنولوجيا”. ربما بهذه الطريقة نصل إلى هذا التوازن الذي يسمح لنا بتمييز الفرق بين الاستخدام وإساءة الاستخدام، لنفهم في الأخير أن المشكلة ليست في التكنولوجيا أو الواقع الافتراضي بل المشكلة فيما نفعله بها.