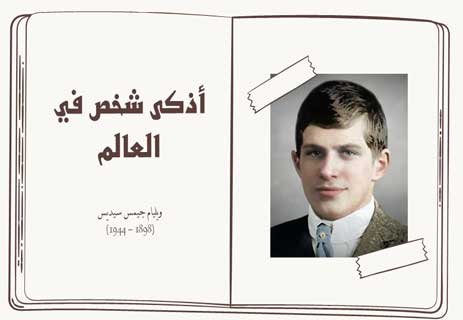تدريب المعلمين بين الواقع والطموح

لا يمكننا بناء مجتمعات قوية دون أن نستثمر في أركانها الأساسية: التعليم والمعلم.. فالمعلم المبدع المجهز بالمعرفة العميقة والمهارات التطبيقية هو الذي يستطيع أن يحمل شعلة الحضارة ليقود أجيالًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.. فهل يمكن أن ينهض المعلم بدوره إذا كان تدريبه قاصرًا، أو إذا كان محاطًا بنظام تعليمي يفتقر إلى الرؤية والموارد؟ دعونا نناقش موضوع تدريب المعلمين بمزيد من التفصيل..
مهمة تدريب المعلمين الصعبة
إن تركيز النقاش التربوي على تدريب المعلمين هو مهمة صعبة، ولكنها ضرورية إذا كنا نرغب في تحقيق تحسينات كبيرة في التعليم على المستوى العام. تكمن الصعوبة في أن التغييرات اللازمة لضمان التدريب الشامل للمعلمين تتطلب تغييرات جذرية في هيكلة الجامعات، والمدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية. علاوة على ذلك، فإن بعض القطاعات التعليمية تنظر إلى فتح النقاش حول نموذج تدريب المعلمين على أنه هجوم. لكن إذا كان علينا مناقشة هذا النموذج، يجب أن نفعل ذلك من خلال تحليل الأخطاء السابقة ومعالجة أوجه القصور في تدريب المعلمين الحاليين.
نحن ندرك أن بعض المهن تتطلب تدريبًا محددًا ومعقدًا وشاملًا. ينظر المجتمع المدني إلى مهنيين مثل الأطباء، أو المهندسين، القضاة باعتبارهم أصحاب مسؤوليات جسيمة، وبالتالي يحتاجون إلى تدريب صارم ودقيق. يمكن للأفضل فقط أن يحصل على دراسات معينة، ويلتحق ببعض التخصصات، ومع ذلك لا ينجح في الاختبارات كل من يفعل ذلك.. لا يندرج المعلمون ضمن هذه الفئة من المهنيين ذوي الكفاءة العالية، ولذلك يبدو من الإجحاف ألا تكون معايير القبول في دراسة التعليم مساوية أو أصعب من تلك الخاصة بدراسة الطب، على سبيل المثال.
إذا توقفنا قليلًا للتفكير سنجد أن مسؤولية التكوين التعليمي والحياتي للأطفال تقع على عاتق المعلمين، وبالتالي هم يحملون أمانة أهم رأس مال في أي مجتمع. لا أنكر أهمية المهن الأخرى، لكنني لا أعتقد أنني أبالغ إذا قلت إن أهمية المعلّمين الاجتماعية تضاهي أهمية الأطباء. يعتني الأطباء بصحتنا وحياتنا، بينما يعتني المعلمون بمستقبل المجتمع. إذًا، لماذا نطلب من الأطباء معايير صارمة لدخول الجامعة، بينما نطلب القليل جدًا من المعلمين؟ قد تكون هذه الأسئلة مزعجة للبعض، لكنها دعوة للتأمل قبل أي شيء.
مكانة المعلم في المجتمع

ينبغي أن تحظى مكانة المعلم باحترام وتقدير أكبر في المجتمع، نظرًا لأهمية الدور الاجتماعي له. ينظر إلى المعلمين في مجتمعنا على أنهم كسالى، وغير أكفاء، ومتغطرسين. هذا الاحتقار لدور المعلم ليس سوى مظهر من مظاهر الازدراء العام الذي يميّز المجتمع تجاه الموظفين الحكوميين. ومع ذلك، أولئك الذين ينددون بهذا الازدراء الظالم لا يمكنهم تجاهل أن المكانة الاجتماعية التي يطالبون بها للمعلمين لا تنشأ تلقائيًا. هذا الاحترام والسلطة، الضروريان لمواجهة المستقبل الجماعي بنجاح، لا يمكن أن يبنيا إلا على أساس مستوى عالٍ من التوقعات تجاه المعلمين الحاليين والمستقبليين.
لذلك، يجب أن يكون أحد الإجراءات الأولى التي ينبغي اتخاذها لإجراء تحول عميق في نظامنا التعليمي هو تغيير نظام القبول في الدراسات العليا المؤهلة للتدريس. يجب إدخال مستوى من الصرامة الأكاديمية يتناسب مع المسؤولية الاجتماعية الكبيرة التي تقع على عاتق المعلمين. ينبغي أن تتبنى الجامعات تدريجيًا نظامًا جديدًا لتأهيل المعلمين، بحيث يكون للتطبيق العملي والبحث التربوي مكانة بارزة.
نظام التعليم في فنلندا
أصبح من المألوف في النقاشات التربوية الإشارة إلى فنلندا كنموذج يحتذى به. ومن الضروري أن تكون تجربة التعليم هناك مصدر إلهام كبير، فهي تظهر بوضوح الحاجة إلى إعادة صياغة مفهوم تدريب المعلمين. ومما لا شك فيه أن مثل هذا النموذج التربوي يجب أن يتم تكييفه مع السياقات المحلية، ولحسن الحظ، وعلى الرغم من العولمة فإن شعوب العالم تحتفظ بطابعها الخاص والمميز، ويجب على الأنظمة التعليمية أن تراعي هذا التنوع وتتكيف مع خصوصيات المجتمعات المختلفة. لذلك، يجب على مجتمعاتنا العربية أن تلاحظ بعناية الهياكل الناجحة التي تطورت داخل المجتمع الفنلندي وتستخلص العِبر منها لتطوير أنظمتها التعليمية.
لا يتعلق الوضع بالنظام التعليمي فحسب، فإذا أظهر النظام الصحي مثلًا في بلد ما كفاءة ملحوظة مقارنة بنظرائه، فهل يمكننا دراسة تدريب العاملين في المجال الصحي وتطبيق بعض أساليبه على النظام التعليمي؟ على سبيل المثال، من البديهي أن الطبيب لا تكفيه المعرفة النظرية بأحد الأمراض إن لم يكن قادرًا على علاج المرضى فعليًا. بمعنى آخر، لا فائدة من المعرفة وحدها إذا لم تطبق عمليًا في الواقع. انطلاقًا من هذا الفهم، يلزم نظام تدريب الأطباء بتطبيق صارم للجوانب العملية.. لا يسمح لأي شخص بالالتحاق بالنظام الصحي العام كمتخصص معتمد ما لم يكن قد خضع لتدريب عملي صارم وتم تقييمه بموضوعية. الجمع بين النظرية والتطبيق ضروري لتكوين كوادر صحية ذات كفاءة. ولكن، أليس من الواضح بنفس القدر أن المعلم، مهما كانت معرفته النظرية واسعة، لن يكون فعّالًا إذا لم يكن قادرًا على تطبيقها داخل الفصل الدراسي؟ يبدو أن هذا الإدراك يتجاوز الفطنة الإدارية لدى القائمين على نظامنا التعليمي.
التطبيق العملي للمعرفة

إن المعرفة الكبيرة التي يتحصل عليها الطلاب في معظم الجامعات لا تعني بالضرورة القدرة على تطبيق هذه المعرفة عمليًا. في الواقع لا استطيع أن أفهم كيف يمكن أن يحصل شخص ما على لقب معلم دون أن يكون قد مارس التدريس فعليًا أو أنجز مشروعًا بحثيًا تربويًا بالتعاون مع المجتمع التعليمي. يحتاج الطبيب إلى فترة تدريب طويلة ليعتبر مؤهلًا، فلماذا لا يطبق هذا المبدأ على المعلمين؟
يتخرج المعلم من جامعته.. ثم يخضع لدورة نظرية مدتها ستة أشهر.. ويقوم بالتدريس ثلاث أو أربع ساعات فقط لطلاب في سن السادسة عشرة. هل هذا كافٍ لتأهيله كمعلم؟ لا أعتقد ذلك. وإذا كنت معلمًا الآن، فليس بفضل ما تعلمته في الجامعة أو خلال تلك الدورة، بل بفضل الخبرة التي اكتسبتها بالتدريس العملي. لكن، هل الخبرة وحدها كافية؟ لا أعتقد أن نظامًا تعليميًا يسمح بأن “يتشكل” معلموه بصورة عشوائية، وبالتعلم أثناء العمل هو نظام جاد. يشبه هذا تمامًا افتراض أن طلاب الطب يمكنهم تعلم كيفية تطبيق معارفهم بشكل ارتجالي دون إشراف صارم من متخصصين.
إصلاح تدريب المعلمين
الإصلاح الأول الذي ينبغي تنفيذه إذن هو توفير الفرصة لطلاب الجامعات الذين يرغبون في توجيه حياتهم المهنية نحو التعليم للقيام بتدريب عملي تحت إشراف من البداية، شريطة أن يضمن نظام التدريب والاختيار تميز هؤلاء الطلاب. ومع ذلك، يبدو أن التكامل التربوي بين الجامعات والمدارس الابتدائية والإعداية والثانوية هو حلم بعيد المنال. هذه القطيعة بين أساتذة الجامعات والطلاب الذين يتأهلون ليصبحوا معلمين وبين المدارس التعليمية هي حالة عميقة وغير منطقية لدرجة تجعلنا نعتقد أن مثل هذا الوضع ربما يكون متعمدًا.
بطبيعة الحال، هناك احتياجات أخرى لتكوين المعلمين قد تتوافق أو لا تتوافق مع احتياجات العاملين في المجال الصحي. على سبيل المثال، في مجتمع اليوم الموصوف بـ”مجتمع المعرفة”، يضطر العديد من المعلمين إلى إعادة التدريب بشكل مستمر.. ما هو الدور الذي يلعبه التدريب المستمر للمعلمين؟ لقد أصبحت الدورات التدريبية للمعلمين في كثير من الأحيان وسيلة لاستنزاف الأموال العامة من قِبل النقابات والمنظمات ذات المصالح الضيقة. والاتجاه الصحيح في هذا الصدد هو تحويل المدارس إلى مراكز تعليمية تشاركية، حيث يكون للمعلمين والآباء والطلاب أدوار نشطة ومتبادلة في عملية التعليم والتعلم.
عندما ندرك أن الشخص لا يمكن أن يكون معلمًا إلا إذا ظل مستعدًا للتعلم، وعندما نفهم أن التعليم هو عملية جدلية يتعلم فيها جميع الأطراف (الطلاب، المعلمون، والآباء) ويعلّمون، سنكون قادرين على إحداث تحول عميق في هيكل نظامنا التعليمي وتكييفه مع عصرنا. عصر التغيير، والحوار المتعدد، حيث يمثل دمج العناصر المتنوعة في المجتمع عاملًا حاسمًا لتحقيق الثراء والتطور.
احترام مهنة التدريس

يمثل تدريب المعلمين أحد الركائز الأساسية التي ستبنى عليها أنظمة التعليم في المجتمعات الأكثر نجاحًا في المستقبل. احترام مهنة التدريس لا يتعارض مع المطالبة بمعلمين أكثر التزامًا وأفضل تأهيلًا، بل على العكس تمامًا، فلا يمكن تحقيق هذا الاحترام إلا إذا كان مدعومًا بمستوى عالٍ من الالتزام المهني الذاتي. يجب أن يبدأ هذا الالتزام منذ سنوات الدراسة الجامعية.. ويبقى مستمرًا طوال الحياة المهنية للمعلمين. ومع ذلك، يصعب تحقيق هذه القفزة النوعية في نظامنا التعليمي طالما بقيت قطاعات كبيرة من الجامعات تتبنى ممارسات انغلاقية.. وتتصرف بلا مسؤولية اجتماعية، وتتواطأ مع السلطة السياسية القمعية.
في مواجهة هذه الطبقة الجامعية، أدرك العديد من الأساتذة الجامعيين أن تدهور التعليم الأساسي والثانوي له نتيجة واضحة: فراغ فكري وافتقار للرغبة المهنية بين طلاب الجامعات.. هذا ما يؤدي في النهاية إلى فقدان القيمة الحقيقية للممارسة التربوية الجامعية. وبناءً على هذا الإدراك، هناك العديد من الجامعيين الملتزمين بجدية بالتغيير التعليمي المنتظر، ولكن المؤسف أن أصواتهم لا تسمع حتى داخل أماكن عملهم.
مشاكل النظام التعليمي
من المستحيل تقريبًا تحقيق تدريب مستمر فعال للمعلمين في ظل الوضع الحالي للنظام التعليمي. المشكلة الأولى ليست نقص الموارد المالية لتحسين التعليم، بل غياب الاحترام الحقيقي لما تعنيه عملية التعليم نفسها. فمع بداية العام الدراسي القادم، ستكتظ فصول المدارس بأكثر من أربعين طالبًا في كل فصل. وسيتعين على هؤلاء المراهقين اجتياز ما بين ثماني إلى إحدى عشرة مادة دراسية خلال العام.
هذا الازدحام، سواء في أعداد الطلاب أو في حجم المواد، يجعل من الصعب تحقيق تعليم مشترك أو متكامل في مثل هذا السياق. وفي ظل هذه الظروف، هل يمكن للمعلم أن يطور مهاراته في شيء غير “أساليب البقاء”؟ إن وجود معلمين مؤهلين لن يكون له قيمة تذكر في بيئة تعليمية متدهورة. حيث يصبح التنوع والحوار شبه مستحيلين.. ويصبح الضجيج هو السمة المسيطرة.
إن المؤسسات التعليمية المزدحمة والمفتقرة إلى الموارد ستنتج مجتمعًا متجانسًا في مستوى متواضع. وإذا كان هذا هو الهدف، فما فائدة تدريب المعلمين بشكل أفضل؟ لكي تؤتي الاستثمارات في تدريب المعلمين ثمارها اجتماعيًا، يجب أن تكون هناك بيئة تعليمية ومناهج مختلفة تمامًا عما هو قائم الآن.
وفي رحلة التعليم، يبقى المعلم هو القلب النابض، والركيزة التي تستند إليها المجتمعات لتنهض من جديد. لكن، لتحقيق ذلك، لابد أن نعيد التفكير في تدريبه وتأهيله، وأن نضع أمام أعيننا صورة أجيال قادمة تسعى إلى المعرفة بفضل معلمين يحملون شعلة التغيير بكل حب وشغف.
حين نصنع معلمين مبدعين وواعين، فإننا نصنع مجتمعًا متجددًا ومتطورًا.. مجتمع قادر على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. وبينما يتردد صدى قاعات الدراسة المزدحمة اليوم، يمكننا أن نحلم بمدارس تتسم بالابتكار، ومعلمين يتجاوزون الحدود، ليغرسوا في قلوب طلابهم حب التعلم وإرادة التغيير.