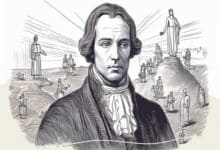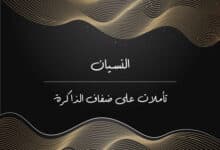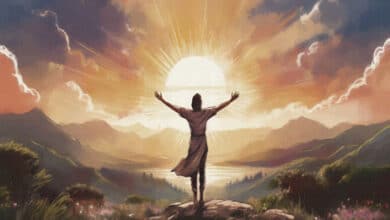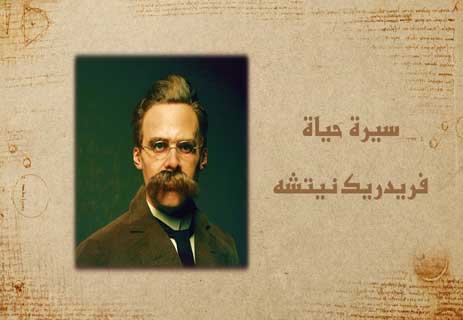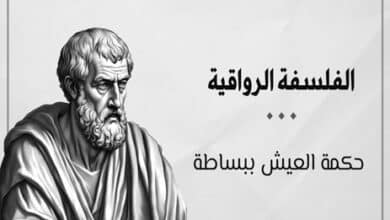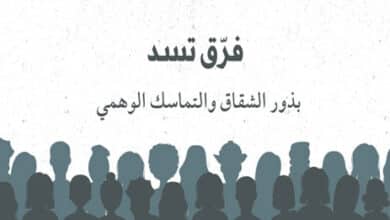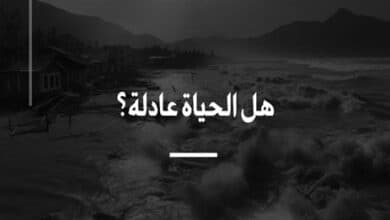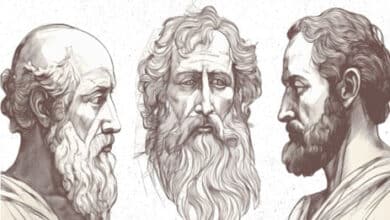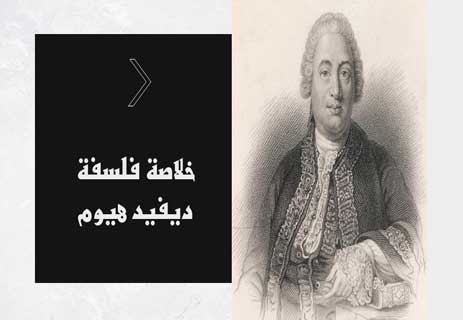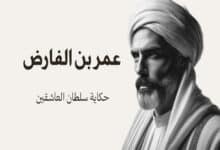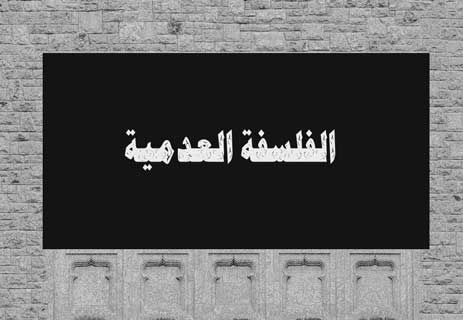اللغة والفكر: الأساس المشترك للوجود الإنساني

اللغة هي الخيط الذهبي الذي ينسج وجودنا الإنساني. إنها الأداة التي أضاءت عتمة الكون الأولي، فاصطنعت الكلمات حدود الأشياء، وأعطت للحياة أشكالها وألوانها. قبل اللغة، كان كل شيء مجرد همسات غامضة وأصداء بلا هوية؛ ولكن مع أول كلمة نطقها الإنسان، بدأت ملامح الوجود تتضح، وصار للصمت منافس. اللغة ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي النافذة التي تطل منها أرواحنا على العالم، والمرآة التي نعكس فيها وعينا بذواتنا. اللغة هي البذرة التي أنبتت الفكر، والمفتاح الذي فتح أبواب الهوية. دعونا نتعرف على العلاقة بين اللغة والفكر بشكل أكثر تفصيلًا..
اللغة كأساس للواقع الإنساني
تستخدم عبارة “نعيش في اللغة” بشكل شائع في الفلسفة للإشارة إلى أن الواقع الإنساني يعتمد على اللغة. اللغة هي النظام الذي نتواصل من خلاله كبشر باستخدام إشارات صوتية يمكن تمثيلها بشكل كتابي. وبما أننا نمتلك القدرة على استخدامها، فإن اللغة تظهر لنا كشرط أساسي لتنظيم العالم بطريقة إنسانية. وبدون هذا النظام من التواصل، لن تكون الحياة كما هي، لأن اللغة تحدد البيئة التي تتحرك فيها حياة البشر.
يحدث أول لقاء لنا مع اللغة عند الولادة، بل يعتقد بعض الباحثين إلى أن ذلك يحدث أثناء وجودنا في رحم الأم. يستقبل الطفل الأصوات الصادرة من فم أمه، ويبدأ تدريجيًا في ربطها بمشاعر معينة. تتوافق الكلمات مع الأحاسيس، مما يجعل عملية التعلم تسلك مسارًا عاطفيًا. هناك أصوات وكلمات قد تثير مشاعر سارة أو غير سارة حسب الحالة أو النغمة أو الجرس التي يميزها الطفل بطرق مختلفة. وهكذا، يبدأ الطفل في تنظيم عالمه بناءً على ما يجذبه أو ينفره، وما يشعره بالراحة أو الخوف، وما يحبه أو يرفضه. وبالتالي، يكون ارتباطه ببيئته ارتباطًا عاطفيًا.
النشأة الأولى

يتعلم الطفل لغته الأم عن طريق التقليد، وهي ليست سوى لغة والديه، ونظام التواصل الخاص بالمجتمع الذي ينتمي إليه. اللغة هي الطريقة التي يتجلى بها الكلام في الواقع. وبهذا المعنى يمكننا القول إن اللغة (كنظام) هي ظاهرة عالمية تنطبق على الجنس البشري بأسره، بينما اللغة الأم (كلسان معين) هي ظاهرة خاصة، تنطبق على مجتمع أو مجموعة اجتماعية محددة، ومن خلال اللغة الأم، يتعرف الطفل على العالم. تُعلّم الأم الطفل أن الكرسي ليس طاولة، وأن الأزرق ليس أحمر، وأن الشجرة ليست طائرًا، وهكذا. ومن خلال التمييز بين الأشياء، يبدأ الطفل في إدراك الفرق بين الأشياء المختلفة. وهكذا، يبدأ الواقع في اكتساب معنى، وتنظيم، وتوزيع، وترتيب.
دعونا نتخيل للحظة أننا نفتقر إلى اللغة. بدون اللغة، سيكون هذا الواقع مجرد “ذلك الشيء”، أي كيان غير محدد يستحيل تعريفه، حيث لا يمكن اكتشاف أجزائه أو تمييز أشياء مثل الطاولة أو الكرسي أو الشجرة. لن يكون هناك شيء ملموس، بل مجرد غيمة ملونة وكثيفة حيث تختفي الأشياء في الكل. فاللغة هي التي تجعل الأشياء تظهر، “تخرج” إلى الواقع، وتتجلى، وتكتسب “وجودًا”.
كان البابليون القدماء يعطون أهمية كبيرة لأسماء الأشياء؛ بالنسبة لهم، ما لم يكن له اسم لم يكن موجودًا، والشيء الذي لا يمكن تسميته لا يمكن إدراجه ضمن العالم، ويبقى، إن صح التعبير، غارقًا في هوة الغموض. ولهذا كان اسم الشخص مهمًا جدًا في الثقافات القديمة؛ لأنه يمنح الفرد “وجودًا” داخل المجتمع.
دور اللغة في بناء “الأنا”

تميز اللغة الفرد أيضًا. الاسم واللقب يمنحان الهوية للشخص؛ قانونيًا، أنا شخص بفضل هذا الاسم الذي حصلت عليه من والديّ. ومن كثرة استخدام اسمي، أتعرف عليه وأرتبط به. أقول: “أنا فلان” هذه العبارة تتضمن إدراكًا للذات، لنفسي: “أنا هو فلان”. ولكن كيف ومتى يظهر هذا الـ”أنا”؟ يبرز هذا السؤال لأنني عندما كنت رضيعًا لم يكن لدي وعي بـ”الأنا”، ولم أكن أعرف أنني كيان مختلف عن أمي.
نجد الإجابة مرة أخرى في اللغة. نحن نتعلم مفهوم الذات خلال عملية نضج الدماغ، عندما يصل إلى مستوى الوعي الذاتي. تخبرني الأم خلال السنوات الأولى أنني لست هي، وهي ليست أنا. لا أفهم ذلك في البداية، حتى يأتي يوم، وبطريقة تشبه الوحي، حيث تُكشف لي فكرة “الأنا”… أقول لنفسي “أنا”. يصعب تحديد ما إذا كانت تجربة الانفصال عن “اللا أنا” هي التي تعرّف “الأنا”، أم أن تسميتي لنفسي بـ”أنا” هي ما تسمح بظهور “اللا أنا”. في كلتا الحالتين، تثير تجربة “الأنا” سؤال وجودي: هل أنا موجود، وإذا كنت موجودًا، فماذا أنا؟ ولماذا أنا موجود؟ ثم نكتشف أن لدينا عالمًا خارجيًا (لا ذاتي) وعالمًا داخليًا (ذاتي).
إن قدرتنا على تسمية أنفسنا بـ”أنا” تجعل من الممكن أن ننظم العالمين: الداخلي والخارجي. لكن، ماذا سيحدث للذات إذا لم تكن هناك لغة؟ إذا تأملنا الأمر، سنجد أننا لن ندرك أننا كيان منفصل عن كل البيئة المحيطة بنا. وسنكون، بطريقة ما، جزءًا لا يتجزأ من العالم، كما هو الحال مع الحيوان الذي لا يبدو أنه يستطيع، حسب معرفتنا، أن ينفصل عن بيئته؛ فهو واحد معها. بدون اللغة، لن يكون هناك “أنا”، ولكن هل سيكون هناك فكر؟
العلاقة بين اللغة والفكر

التفكير مبني على المفاهيم، وهي مفاهيم نكوّنها بفضل اللغة. تشبه اللغة سكينًا يقطع لوحة العالم لتبرز شيئًا ما عن طريق تسميته. تعيرنا الأم سكينها مرارًا وتكرارًا: “هذا كرسي”، وتكرر، “وهذا أيضًا كرسي، وكذلك هذا”. نفهم تدريجيًا أن الكرسي هو شيء ذو شكل معين يُستخدم للجلوس، ثم نضم كل شيء مشابه إلى مفهومنا عن الكرسي. وعندما يقول أحدهم “كرسي”، أفكر في كرسيي الخاص، كرسي متخيّل، لكنه كرسي يتماشى تمامًا مع نية من أطلق عليه هذا الاسم. وبهذه الطريقة، أتمكن من مشاركة عالمي مع عوالم الآخرين والتفاهم معهم. إن الكون الإنساني هو كون مفاهيمي مشترك يعمل عند استخدام لغة مشتركة.
لو لم نكن نعيش في اللغة، لما استطاع التفكير أن يعالج المفاهيم، ولتعذر علينا تنظيم الأفكار. عندما نفكر، فإننا نقول لأنفسنا ما نفكر فيه. ولهذا يقول الفيلسوف الألماني هانز جادامير:
التفكير هو حديث مع النفس…
يمكننا أن نستنتج أن اللغة ممكنة بفضل العقل البشري، لأن نظامًا كهذا لا يمكن أن يوجد إلا في كائن يمتلك قدرات عقلانية مثل قدراتنا. ومع ذلك، بدون اللغة، لا يوجد تفكير، لأن التفكير يعتمد عليها لتنظيم الأفكار المنطقية المستندة إلى مفاهيم منشؤها اللغة. وبدون التفكير، لن يكون هناك “أنا”، لأن “الأنا” تعني امتلاك القدرة على التفكير في الذات، التأمل في الذات، وتوجيه الانتباه إلى هذا الكيان الذي أنا عليه، كيان منفصل عن العالم.
اللغة ليست فقط ما يربطنا بالآخرين، بل هي ما يربطنا بأنفسنا، وما يجعلنا قادرين على مواجهة أسئلة الوجود الكبرى. لولا اللغة، لبقينا أسرى الصمت، تائهين في لجة المجهول. إنها شعلة الفكر ووهج الإبداع، وبدونها، لن يكون هناك فكر ولا وعي، فقط عالم صامت كبحر بلا أمواج.