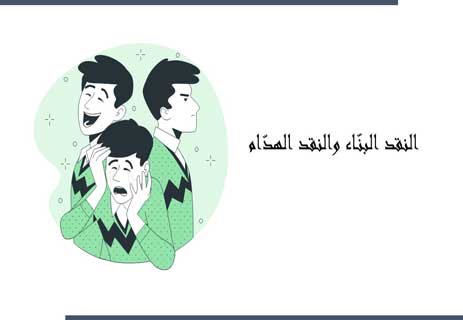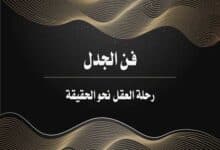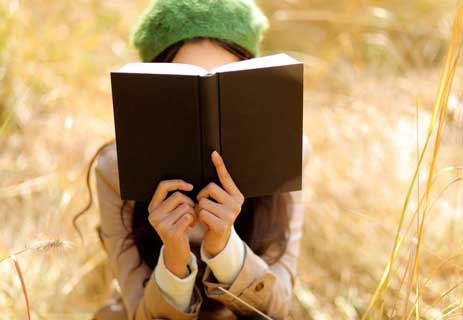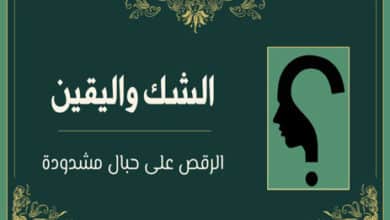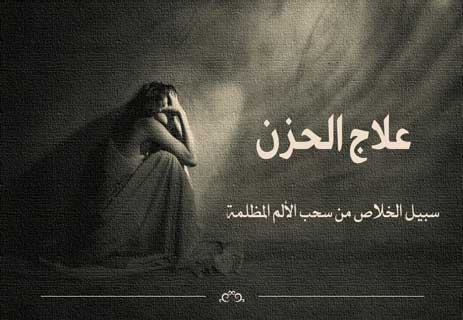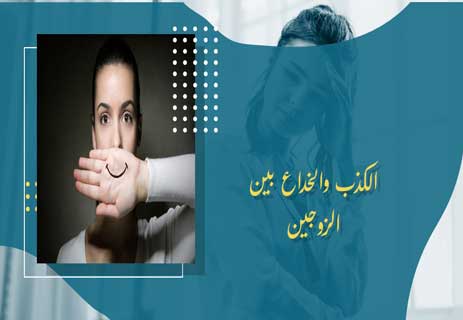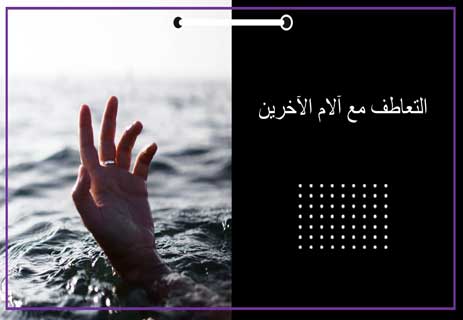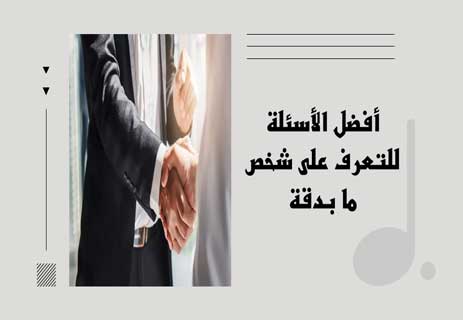التشوهات المعرفية: هل نحن أسرى لأنماط تفكير خاطئة؟

تتعامل عقولنا مع قدر هائل من المعلومات كل يوم دون أن ندرك ذلك، فهناك الكثير من المحفزات من حولنا (التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات، الأفلام والمسلسلات) مما يدفعنا إلى تصفية كل هذه المعلومات، ومحاولة تسهيل الأمور على أنفسنا، ولكننا نقع أحيانًا في فخ التشوهات المعرفية. ربما تتساءل: وما هي التشوهات المعرفية؟ ببساطة، هي طرق مختصرة نستخدمها لجعل حياتنا أسهل، ولكن إذا استخدمناها بشكل عشوائي، فقد تؤدي إلى عواقب سلبية مثل ظهور مشاعر قوية لا نعرف كيف نديرها، أو صراعات مع الآخرين، أو التأثير على طريقة رؤيتنا للحياة وما يحيط بنا. في هذا المقال، سأخبرك عن التشوهات المعرفية، وسأتحدث عن أكثرها شيوعًا، وفي النهاية سنرى ما يمكننا فعله لتجنب الوقوع في شباكها..
تعتقد أن عليك أن تتعامل مع العديد من الصعوبات، لكن الحقيقة هي أن الصعوبة الأكبر موجودة بداخلك وأنت أكبر عائق أمام نفسك – سينيكا
ما هي التشوهات المعرفية؟
التشوهات المعرفية هي تغييرات في طريقة رؤيتنا للأحداث، وكأننا نرتدي نظارات غير مناسبة تشوه إدراكنا. وقد يكون الهدف منها جعل الواقع يبدو متسقًا أو متماشيًا مع معتقداتنا غير المنطقية. إن ما يحدث من حولنا ليس هو السبب المباشر وراء انفجار مشاعرنا، بل الطريقة التي ندرك بها تلك الأحداث، والطريقة التي نفسرها بها. تكمن خلف كل شعور سلبي، مثل الحزن، الغضب، الخوف، القلق والتوتر، وغيرها، أفكار خفية في العقل تمنعنا من رؤية الواقع كما هو. تُعرف هذه التغيرات في إدراك الواقع باسم التشوهات المعرفية.
يمكننا أن نفهم التشوهات المعرفية كطريق مختصر نلجأ إليه عندما نكون في عجلة من أمرنا عند الذهاب إلى العمل، لكننا نأخذ الطريق الخطأ، ونصل متأخرين في النهاية. في البداية، نستخدم التشوهات المعرفية لتسهيل حياتنا، ولكن قد لا تكون مفيدة كما تبدو. ولهذا السبب، من المهم أن نخصص لها مساحة لفهمها وتحديدها، دون الشعور بالذنب أو الانزعاج أو معاقبة أنفسنا.
أنواع التشوهات المعرفية

إن المواقف أو التجارب نفسها ليست هي المسؤولة الوحيدة عن الطريقة التي نشعر أو نتصرف بها، بل إن الأفكار وتحديدًا التفسير والمعنى الذي نعطيه لما نعيشه هي ما تلعب الدور الأهم.. وهذا هو المكان الذي تظهر فيه التشوهات المعرفية التي تولد لدينا مشاعر وعواطف معينة تدفعنا للتصرف بطرق محددة. لذلك، يجب علينا معرفة أبرز التشوهات المعرفية الشائعة كي نستطيع تجنبها..
التفكير الثنائي (الأبيض/ الأسود)
نلجأ إلى هذا النوع من التفكير عندما نُفسر ما يحيط بنا من حيث كونه جيد/ سيء، حقيقة/ كذب، أبيض/ أسود، دون الأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل والتدرجات التي توجد بين الأبيض والأسود في كل موقف. على سبيل المثال رسبت سارة في امتحان العلوم، فاستنتجت أنها شخص فاشل، وبالتالي لن تتمكن من اجتياز الامتحانات الأخرى.. يمكننا هنا ملاحظة أن سارة لم تعر الانتباه إلى التفاصيل أو الجوانب الأخرى للوضع، فربما لديها مشكلة فقط مع العلوم، أما باقي المواد فقد تكون جيدة فيها..
هذا النمط من التفكير قد يجعل المرء يفقد الحافز وينحرف عن مساره، وربما يتخلى عن هدفه بالكامل. لذا من المهم لتجنب هذا النوع من التفكير أن ننظر إلى الأمور بشكل نسبي؛ خطأ واحد لا يعني فشلًا كاملًا، وعلينا أن نتقبل وجود هامش للخطأ، فلا أحد مثالي. كما يمكننا أن نستفيد من هذا الموقف في تحديد ما فشلنا فيه وتقييم الوضع ومحاولة إصلاحه، وهذا ما يساعدنا على التعامل مع الأمور بواقعية أكبر..
التعميم المتحيز
التعميم المتحيز هو الميل إلى استخلاص استنتاج عام بناءً على حدث واحد فقط، دون وجود أدلة كافية تدعم هذا الاستنتاج. دعونا نوضح ذلك بمثال: يمر عمر بفترة يشعر فيها بالإحباط والحزن وقلة الحافز لفعل أي شيء، مما يدفعه إلى التفكير قائلًا: “سأشعر هكذا دائمًا”.. “هذا يحدث لي دائمًا”.. “ليس لدي حظ أبدًا”.. “الكل يفعل هذا”.. “لا أحد يفهمني”..
إن استخدام كلمات مثل “الكل، لا أحد، دائمًا، أبدًا” تشير إلى أننا نقع في فخ التعميم المفرط.. يظهر هذا النمط من التفكير بشكل أكثر تطرفًا عند تصنيف الأشخاص أو المواقف بناءً على حدث واحد.. إذا تأخر شخص مرة واحدة؛ فهو شخص غير ملتزم.. وإذا فشل شخص في اختبار القيادة؛ فهو عديم الفائدة..
يمكن للمرء أن يختبر نفسه عند التفكير بهذه الطريقة.. كم مرة حدث ذلك بالفعل؟ ما الأدلة التي تؤكد هذا الاستنتاج؟ وهل هناك حالات لم يحدث فيها ذلك؟ إن التركيز على الحقائق بدلًا من الافتراضات لهو أمر ضروري في تفسير الأحداث والمواقف، لذا يمكن للمرء أن يحاول أن يكون أكثر مرونة في تفسيره للأحداث، وتجنب إطلاق الأحكام العامة على نفسه أو على الموقف بناءً على تجربة واحدة فقط..
التصفية السلبية
يتمثل هذا النمط في تركيز كل انتباهنا على تفصيل واحد في الموقف، متجاهلين السياق العام أو الجوانب الأخرى، ونحدد التجربة بأكملها بناءً على هذا التفصيل الوحيد. بعبارة أخرى، نقوم بتصفية السلبيات ونتجاهل الإيجابيات. دعونا نوضح ذلك بمثال: خرج آدم مع زوجته لتناول الطعام بعد انتهاء عملهما. تحدثا عن الرحلة التي يخططان لها في هذه الإجازة، شعرا بالحماس والبهجة، ولكن أثناء الحديث تطرقا إلى مشكلة حساسة بينهما. شعر آدم بالغضب والندم لأنه قرر الخروج معها بدلًا من العودة إلى المنزل مباشرة.. هنا يمكننا أن نلاحظ أن آدم تجاهل الحديث الممتع حول الرحلة وركز فقط على الموضوع السلبي الذي أثار انزعاجه..
نحن نميل إلى استخدام عبارات مثل “هذا لا يحتمل.. لا أستطيع تحمل.. لقد سئمت”.. ولكن بمجرد أن ندرك هذه التفسيرات، يمكننا أن نأخذ خطوة للوراء ونتساءل: ماذا حدث في مناسبات أخرى عند الحديث مع هذا الشخص؟ هل أشعر بالسوء دائمًا في وجوده/وجودها؟ هل كانت كل المحادثة غير سارة بالفعل؟ ماذا يمكنني أن أفعل إذا تكرر ذلك في المستقبل؟ ما يمكننا فعله هو التركيز على الصورة الكاملة بدلاً من التفاصيل السلبية فقط. وملاحظة اللحظات الإيجابية ومنحها نفس الوزن الذي نمنحه للسلبيات، وأخيرًا التخطيط لاستراتيجيات للتعامل مع المواضيع التي تثير انزعاجنا مستقبلاً..
قراءة الأفكار
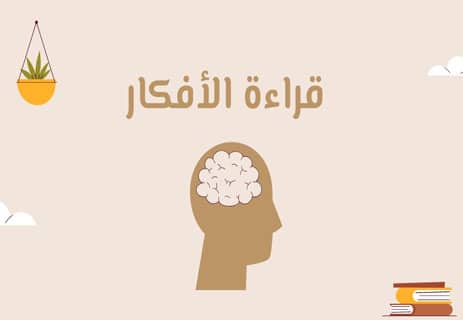
يحدث هذا عندما تتظاهر بمعرفة ما يفكر فيه الآخرون، وما يشعرون به، وتقوم بوضع نظريات حول هذا الموضوع، بناءً على مجرد الافتراضات. على سبيل المثال، “الجميع يكرهوني في العمل، ولكنهم يخفون ذلك”.. أو “لم يعد يحبني زوجي، ويبقى معي فقط بدافع الشفقة”..
يمكننا اكتشاف ذلك من خلال استخدامنا لكلمات مثل “هذا بسبب..” أو “أعلم أن هذا يحدث لأنه..”.. وما يجب علينا فعله هو التوقف عن الافتراض والبدء بالحديث في حالة الشك في أحبائك. قم بتحليل أفكارك وحاول التحقق مما إذا كانت مجرد أحاسيس أم أن لديك أسبابًا محددة للتفكير بهذه الطريقة. حدد المواقف التي تولد القلق وانعدام الأمان وتجعلك تتصرف بهذه الطريقة.
التنبؤات الكارثية
يتمثل هذا التشوه المعرفي في المبالغة في أهمية كل ما يحدث لنا، وتحويل موقف بسيط إلى مشكلة ضخمة، بالإضافة إلى القفز إلى استنتاجات متسرعة وسلبية دائماً، ووضع نفسك في أسوأ السيناريوهات.. دعونا نوضح ذلك بمثال، ستسافر زوجة عمر إلى الخارج لحضور مؤتمر علمي، لكن عمر منذ أخبرته زوجته أنها ستغادر في غضون أيام قليلة، بدأ يفكر في احتمال تعرضها لحادث، وظل قلقًا حتى وصلت إلى وجهتها.. مثال آخر عندما ترى حجم الكوارث والأمراض والمآسي في العالم، تسأل نفسك: ماذا لو حدث لي هذا أيضًا؟
يمكننا التعامل مع هذا النمط من التشوهات المعرفية من خلال تحليل ما نشعر به حقًا: هل هذه المشكلة خطيرة إلى هذا الحد؟ وهل لديك أي حل؟ هل أنت أول شخص حدث له هذا؟ كيف ستبدو هذه المشكلة بالنسبة لك بعد مرور ثلاثة شهور أو ثلاث سنوات؟ باختصار، خذ مسافة لإعادة ضبط إدراكك.. إن وضع نفسك في أسوأ الأحوال ليس من الواقعية في شيء، والبديل ليس توقع الأسوأ، بل تركيز الانتباه على الحاضر، وبناء وجهات نظرنا على الحقائق الموضوعية للوضع الحالي..
مغالطة التحكم
في هذا النوع من التشوهات المعرفية، نفسر التحكم في الموقف بطريقة “الكل أو لا شيء”.. يمكن أن نميل إلى التحكم الخارجي؛ بمعني التفكير بأن حياتنا بالكامل تخضع لعوامل خارجة عن سيطرتنا ولا يمكننا التحكم بها، أو التحكم الداخلي؛ بمعنى الاعتقاد بأن كل شيء يحدث لنا هو مسؤوليتنا الكاملة وأنه يعتمد علينا فقط.
راقب الطريقة التي تتحدث بها إلى نفسك؛ فإذا كنت تقول: “أنا المسؤول عن كل ما يحدث لي” (تحكم داخلي).. أو “لا شيء من هذا يعتمد علي، كل شيء بسبب القدر” (تحكم خارجي). ثم اطرح هذه الأسئلة على نفسك: ما الأدلة التي أملكها لتأكيد أن “س” يعتمد فقط عليّ أو فقط على محيطي؟ هل توجد عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على هذه الحالة؟ وعليك أن تعترف بأن الحياة مزيج من العوامل الداخلية (قراراتك وأفعالك) والخارجية (البيئة والظروف). ولا تُحمّل نفسك المسؤولية الكاملة عن كل شيء، ولا تضع نفسك في موقف العجز بسبب الظروف الخارجية. حدد ما يمكنك التحكم فيه بالفعل وما لا يمكنك التحكم فيه. وركز على الجوانب التي يمكن التأثير عليها، واترك الأمور الخارجة عن إرادتك.
الشخصنة
الشخصنة هي الميل إلى ربط أحداث البيئة المحيطة بأنفسنا. لنوضح ذلك بأمثلة: يشعر سمير أنه كلما تحدثت إليه مديرته عن ضرورة أخذ العمل بجدية أكبر، فإنها تقصده فقط بهذا الحديث”.. “إذا شعرت بالقلق، فهذا لأن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث لي”.. “وإذا شعرت بالغضب، فهذا لأنني أتعرض للهجوم”.. “إذا شعرت بالإهانة، فهذا لأن الآخرين يقللون من احترامي”.. “إذا شعرت بعدم الراحة، فهذا لأنني غير مقبول هنا أو لأنني غير مرحب به”..
هذا النمط من التفكير يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستقبل، حيث يصبح الشخص مقتنعًا بأن أي شعور سلبي ينبئ بحدث سلبي قادم. وقد يؤدي ذلك إلى تقييم المواقف بناءً على ردود أفعالنا العاطفية فقط، مما يجعلنا نرى الأمور من منظور مشوه. مثل هذه الأفكار تغذي السلوكيات التجنبية التي تدفعنا للهروب من كل ما يسبب لنا مشاعر سلبية أو مزعجة. وعلى الرغم من أن هذا قد يخفف من المشاعر في اللحظة الحالية، فإنه على المدى الطويل يؤدي إلى العزلة وتقييد الحياة..
اسأل نفسك: ما الذي حدث فعليًا ليجعلني أشعر بهذه الطريقة؟ هل هذا مجرد انطباع شخصي؟ هل لدي أدلة واضحة تثبت صحة اعتقادي؟ طرح هذه الأسئلة يساعدك على رؤية الموقف بموضوعية والتخلص من الاستنتاجات الخاطئة التي تبنى فقط على المشاعر. إجراء هذا النوع من التفكير الناقد يمكن أن يساعدك على تقليل تأثير الشخصنة ورؤية المواقف بموضوعية أكبر.
مغالطة الإنصاف

يحدث هذا التشوه المعرفي عندما تعتبر أن الأشياء أو المواقف أو الأشخاص الذين لا يتوافقوا مع معتقداتك وتوقعاتك غير منصفة وظالمة. على سبيل المثال، ترفض والده مريم أن تخرج ابنتها في نزهة مع صديقاتها، لأن لديها اختبارات في مدرستها. تعتقد مريم أن والدتها لا تحبها، وتقول: “لو كانت تحبني، لما قالت ذلك.. ولسمحت لي بالخروج”..
يمكننا الكشف عن هذه المغالطة من خلال تركيز انتباهنا على استخدامنا لعبارات مثل: “هذا ظالم…” أو “ليس من حقهم أن…”. بناءً على ذلك، علينا أن نفرق بين ما نرغب فيه بشكل شخصي وما نعتبره عادلاً أو غير عادل. كما ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن للناس الحق في التفكير بطريقة مختلفة، وأن الأمور لا تسير دائمًا كما نرغب. إذا كنت تغضب من الآخرين لأنهم مختلفون، أو يفكرون بشكل مختلف، وإذا بدا عليك الحسد لأن الآخرين يحققون الكثير، ويعملون أقل منك، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الغضب والإحباط والعدوان.
هناك بعض الحيل السهلة لكسر نمط التفكير هذا. توقف عن الحكم، فقط راقب. تعلم من نجاح الآخرين بدلا من زراعة الحسد. لا تتوقع أن يكون العالم أو الآخرين عادلين معك، فالحياة ليست جيدة أو سيئة، عادلة أو غير عادلة. ولا تتجول وأنت تتمنى أن يعاقب العدل الإلهي الظالمين. يحصد الجميع عواقب أفعالهم ولكن هذه ليست مشكلتك. وتذكر أن فكرة العدالة هي مجرد فكرة مستمدة من تصورك.
مغالطة التغيير
يتمثل هذا النوع من التشوهات المعرفية في الاعتقاد بأن رفاهيتنا وسعادتنا تعتمد بشكل كامل على أفعال الآخرين، مما يؤدي إلى استنتاج أنه لتلبية احتياجاتنا، يجب على الآخرين أولاً تغيير سلوكهم. لنوضح هذه الفكرة بمثال: تعتقد سارة أن علاقتها بزوجها ستتحسن عندما يغير زوجها سلوكه، ولا ترى في نفسها أي مشكلة..
يظهر هذا التشوه المعرفي في كلمات مثل “أنا على حق.. هو على خطأ.. أعلم أنني على حق”.. توقف لحظة وفكر: هل تعتقد أن رفاهيتك تعتمد بالكامل على تصرفات شخص آخر؟ الحل هو غرس الاحترام والتوقف عن التركيز على نفسك وتعلم الاستماع للآخرين، واعتبار أن لهم الحق في أن يكون لهم رأيهم الخاص، وربما يمكنك أن تتعلم منهم من خلال الاستماع إلى وجهة نظرهم.. ركز على ما يمكنك فعله بالفعل، فليس كل شيء يعتمد على الآخرين. لدينا دائمًا مساحة للعمل والتغيير..
الوصم الخاطىء
يحدث هذا التشوه المعرفي عندما نقوم بإلصاق صفات معينة على الآخرين أو على أنفسنا، وذلك حين نختزل كيانًا كاملاً في كلمة واحدة تلخصه. تكمن مشكلة الوصم الخاطىء في أنها قد تؤدي إلى رؤية العالم والناس بطريقة نمطية. على سبيل المثال، وصف شخص بأنه “خجول” لأنه انطوائي. هنا، نختزل جميع خصائص هذا الشخص المتعددة في تصنيف واحد. اسأل نفسك: ما هي التأثيرات التي قد تترتب على هذا التصنيف؟ وهل هناك جوانب لهذا الشخص أو لنفسك تتجاوز هذا التصنيف؟
يجب عليك
تتمثل هذه المغالطة في التمسك بقواعد صارمة وغير قابلة للتغيير حول كيفية سير الأمور. إذا حدث انحراف أو تغيير، يُعتبر الأمر غير مقبول ويؤدي إلى مشاعر سلبية قوية. على سبيل المثال، يُصاب معلم بالإحباط من طلابه لأنهم حصلوا على درجات سيئة في آخر اختبار، ويفكر: “كان يجب عليهم الدراسة أكثر، وكان عليهم أن يأخذوا مادتي بجدية أكبر”. هذا التفكير يمنع المعلم من التحدث مع طلابه بلطف حول الصعوبات التي يواجهونها لتكييف المحتوى بما يسهل عليهم فهمه.
يمكن التعرف على هذا النمط من التفكير في استخدام عبارات مثل “يجب أن..” أو “لا ينبغي أن..” أو “ما كان يجب عليك..” هذه العبارات تكشف القواعد الصارمة التي يتبعها الشخص، وخلف هذه السلوكيات تختبئ أفكار جامدة وغير مرنة يجب أن تغيرها، يجب أن نخفض مطالبنا على أنفسنا والآخرين ونتذكر أن هدف الآخرين والعالم بشكل عام ليس إرضائك.
مغالطة المكافأة الإلهية

تحدث هذه المغالطة عندما نعتقد أن المشكلة ستُحل من تلقاء نفسها. نترك الأمور للوقت أو الحظ دون السعي لحل فعلي. ما يحدث في هذه الحالة هو أن الشخص يراكم مشاعر سلبية بمرور الوقت، بينما تظل المشكلة دون حل لأنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لمعالجتها.
على سبيل المثال، يشعر ياسين بالغضب منذ عدة أسابيع تجاه صديقه يونس، الذي يصل دائمًا متأخرًا. لكنه قرر تحمل الأمر معتقدًا أن يونس سيدرك مع الوقت كل ما يفعله ياسين من أجله وسيعتذر. ومع ذلك، لا يحدث هذا، ويبدأ ياسين في التصرف ببرود كلما التقى به.. إن انتظار أن تحل المشاكل نفسها أو أن يفهم الآخرون مشاعرنا دون أن نوضحها قد يؤدي إلى تراكم الإحباط. لذلك من الأفضل مواجهة المواقف بوضوح والبحث عن حلول بنّاءة..
تمارين حول التشوهات الفكرية
ناقشنا خلال المقال التشوهات الفكرية الأكثر شيوعًا واستراتيجيات للتعرف عليها وإدارتها. الآن سنضع تمرينًا صغيرًا يمكن أن يساعدك في التعامل مع أي من هذه التشوهات:
- انتبه لأفكارك وكلامك: هل تستطيع التعرف على أي من التشوهات المذكورة؟
- قيم تأثيرها: كيف تفيدك هذه التشوهات وكيف تضرّك؟
- تحرك نحو التغيير: فكّر في كيفية تعديل أفكارك لتجنب الوقوع في هذه الديناميكيات..
نصيحة إضافية
استخدام التشوهات الفكرية أمر شائع في حياتنا اليومية، وهو طبيعي، إذ لا يمكننا معالجة كل هذا الكم من المعلومات دفعة واحدة. لكن التعرف على هذه التشوهات وإدارتها هو المفتاح. خذ وقتك، وابدأ بخطوات صغيرة ومتأنية؛ هذا هو أفضل نهج للتعلم. وكما يقول كارل بوبر:
الجهل الحقيقي ليس غياب المعرفة، بل رفض اكتسابها..
وفي الختام، أود التأكيد على أنه على الرغم من أن التشوهات المعرفية هي معتقدات أو أفكار غير عقلانية، إلا أنها تجلب مشاكل وتسبب معاناة نفسية حقيقية للغاية. إنها تعمل كحلقة مفرغة تحبسك: تبدأ بفكرة، ثم تصبح شعورًا، ثم تصبح إحساسًا، وتؤدي في النهاية إلى السلوك. يمكن أن تصل بك التشوهات المعرفية إلى اضطرابات شخصية حقيقية، مما يسبب الاكتئاب، والاضطرابات النفسية، وحتى الميل إلى الانتحار. إن معرفتها، ومعرفة كيفية التعرف عليها، هي الخطوة الأولى لتعديل أنماط التفكير الخاطئة التي تبطئ تقدمك وتقوض رفاهيتك.
مراجع
|
1. Author: Katerina Rnic, David J A Dozois, and Rod A Martin, (08/19/2016), Cognitive Distortions, Humor Styles, and Depression, www.pmc.ncbi.nlm.nih.gov, Retrieved: 02/28/2025. |
|
2. Author: Caroline M. Pittard & Patrick Pössel, (01/01/2020), Cognitive Distortions, www.link.springer.com, Retrieved: 02/28/2025. |
|
3. AuthorJohan Bollen, Marijn ten Thij, Fritz Breithaupt, and Marten Scheffer, (07/23/2021), Historical language records reveal a surge of cognitive distortions in recent decades, www.pnas.org, Retrieved: 02/28/2025. |