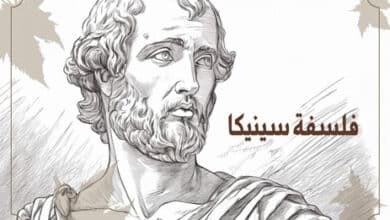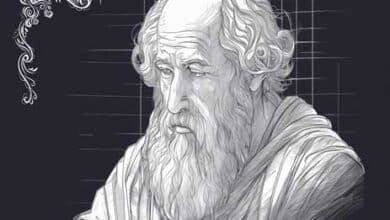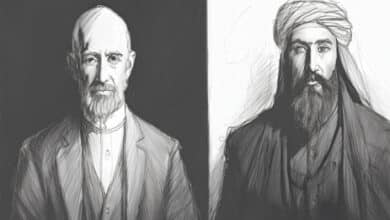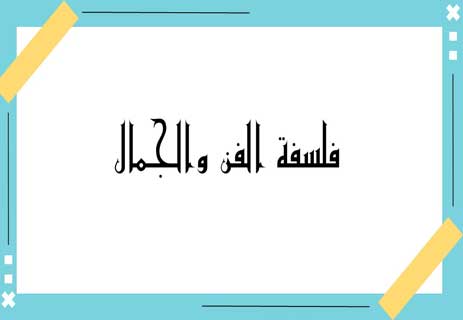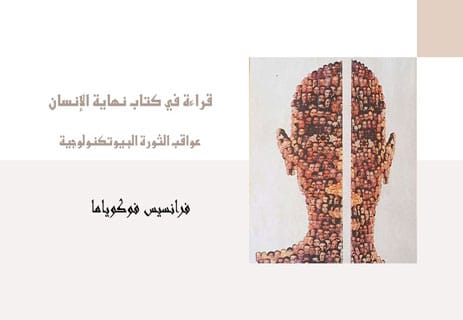وفاة شخص عزيز: همسات من العالم الآخر

يقال إن الضياع هو الثمن الذي ندفعه لحب كان يومًا يسكن قلوبنا، لكن من ذا الذي يستطيع أن يتحمل قسوة الرحيل؟ حين يفارقنا من نحب، لا نكف عن البحث عنه بين تفاصيل الأيام، وفي زوايا الذكريات، وبين ظلال الأماكن التي شهدت ضحكاتهم. يصبح الحنين طيفًا ملازمًا، يطرق أبواب القلب في لحظات السكون، فتفيض الروح وجعًا، ويصبح الزمن مجرد شاهد صامت على غياب لا يُعوّض. إن وفاة شخص عزيز ليست مجرد لحظة رحيل، بل زلزال يهز أركان الحياة، يبدّل ألوانها، ويترك خلفه فراغًا لا يملؤه شيء.
قبول الغياب والألم..
إن وفاة شخص عزيز هي تجربة مدمرة تجبرنا على إعادة تعريف أنفسنا، وخاصةً إذا كانت هناك علاقة ترابط عاطفي مع المتوفى، وهو ما يحدث في كثير من المواقف. حيث نكون قريبين جدًا من شخص آخر لدرجة أنه يملأ جزءً من حياتنا عاطفيًا وعقليًا. وعندما يرحل لا يتبق لنا سوى شعور بالفراغ من المستحيل ملئه. إن التعلق بالآخرين أمر لا مفر منه.. كما هو الحال مع الروتين والخطط المستقبلية. حيث نعول على وجود ذلك الشخص الذي لم يعد موجودًا والذي يفرض غيابه علينا إعادة التكيف. ولهذا تعتبر وفاة شخص عزيز بمثابة التخلي عن جزء من أنفسنا، ودفنه هناك بجوار من مات..
يجعلنا هذا التخلي الذي نسميه الحزن، نمر بفترة من الانفصال، حيث نشعر بالضعف. البعض يبكي، والبعض الآخر يبحث عن العزلة والصمت.. وهناك من يحاول تخطي هذه المرحلة من العملية بتكاليف يصعب تقديرها وتزيد من هشاشتنا. من الصعب التفكير بأن هذا الشخص لم يعد موجودًا، ولا سبيل لتقبل غيابه.. كانت المساحة التي يسكنها مليئة بحضوره لدرجة أن كل شيء من حولنا بمثابة ذكريات تحمل في طياتها المودة والابتسامات والألم.. لكن مع مرور الوقت يتحول الأمر ببطء إلى روتين ثم إلى طقوس، وينتهي بنا الحال إلى الذهاب إلى المقبرة في ذكرى وفاته وإحضار الزهور، وتغيير الماء للنباتات، والبقاء لبضع دقائق أمام قبره والتفكير في كل ما مررنا به معًا، ثم نتقبل الغياب والألم أيضًا..
نصف أحياء ونصف أموات

عندما يرحل شخص عزيز يدخل الموت إلى حياتنا، ولا يعني هذا أن الموت لم يكن موجودًا من قبل، لأنه موجود دائمًا، لكن الموت كاحتمال، كلحظة تأمل، كجزء من الحياة.. الموت كطقس يومي لا نستطيع إنكاره، على الرغم من أسلوب حياتنا الذي لا مكان للموت فيه..
تحدث الرواقيون عن الموت باعتباره جزءً من الحياة لا ينبغي تجاهله، لأننا بقبوله، نصبح أقوى.. نعيش لأنفسنا وأيضًا لأولئك الذين لم يعودوا هنا، لأن أحد معاني الموت هو أن ندفع أنفسنا إلى الحياة دون استسلام. لا شك أن الأمر هكذا، تذكرنا وفاة شخص عزيز بأننا نحيا وسنموت، ولكن مع الراحلين نعيش نصف أحياء ونصف أموات في مقبرة معطرة بالزهور التي نزورها في كل مناسبة.. يموت المرء حيًا ويعيش ميتًا بلا مفر ولا عزاء.
نعلم أننا سنموت، رغم أننا لا نقبل ذلك أبدًا؛ فموتنا الشخصي ليس تجربة نعيشها أثناء حياتنا، لذا يبدو الموت كتهديد مجرد، كظل نلمحه بطرف أعيننا بين الضباب. يُقال غالبًا: «الموت يصيب الآخرين فقط»، وقد عبّر أبيقور عن ذلك ببساطة بليغة:
ما دمنا موجودين، فالموت ليس موجودًا، وعندما يحضر الموت، لن نكون موجودين..
ومع ذلك، فإن فناء الآخرين حقيقة تفرض نفسها علينا بكل قسوتها. يرحل الأحبة ولا يعودون أبدًا، وفي غيابهم الذي «سيستمر ويستمر» يتجسد الفراغ المدمر الذي تتركه الخسارة فينا إلى الأبد. ومن المعروف أن للحِداد مراحل: نبدأ بالتمرد والإنكار، ثم يخضعنا الزمن وواقع الحياة القاسي، حتى نستسلم أخيرًا لحقيقة لا تقبل الجدل.
ذكريات في طيات النسيان

ولكن ربما لا تلتئم الجراح أبدًا بشكل كامل. حيث تتشابك الحياة والموت بطريقة غامضة، كما تروي لنا الأساطير وحكايات الأرواح العديدة. نزل أورفيوس إلى العالم السفلي لإنقاذ محبوبته يوريديس، لكنه فقدها بمجرد أن استدار لينظر إليها؛ فالذكرى الحتمية للموتى تعيد إحياءهم في أذهاننا، لكنها في الوقت نفسه تؤكد غيابهم.
كان أرواح الأسلاف حاضرة بقوة في الوجدان الجمعي في المجتمعات القديمة، لكن العلاقة معهم كانت ملتبسة: فمن جهة، كانوا محبوبين ومكرمين، يُطلب منهم الحماية، لكن في الوقت ذاته كانوا مصدر رهبة وخوف، وذلك عن حق، لأن جزءًا منا يتوق لترك كل شيء خلفه ومرافقتهم إلى العالم الآخر.
لكن العالم الآخر، في حقيقة الأمر، يسكن داخلنا. فالموتى يريدون الرحيل، ولا يريدون أن يقبع الأحياء في دائرة الحزن. وإذا ظلوا جزءً من حياتنا، فذلك لأن الإنسان كائن من الذاكرة. فرغم أننا نعيش في الحاضر، فإننا لا نتوقف عن إسقاط ذواتنا نحو الماضي والمستقبل، فنُشبع الزمن بتوقعاتنا وذكرياتنا. وهكذا، يبقى الراحلون متقدين في جمر القلب.
وبما أنهم باقون، يمكننا محادثتهم، ولديهم الكثير ليقولوه لنا. وأهم ما يخبروننا به: أننا يومًا ما سنكون إلى جانبهم، وسيتحول كياننا بدوره إلى ذكرى. ولكن حتى هذه الذكرى ستتلاشى تدريجيًا، متآكلة بفعل الزمن، حتى تختفي تمامًا في طيات النسيان. إن التصالح مع هذه الحقيقة والتحديق في وجهها مباشرةً قد يكون أمرًا مُلهمًا: فالموتى هم الطليعة التي تسبق موتنا الشخصي. هم السابقون، المسافرون الذين يطمئنوننا بمثالهم، ويخففون من وطأة خوفنا أحيانًا. حتى لمن لا يؤمن بعالم آخر، ثمة شيء دافئ في فكرة أننا سنرحل يومًا ما برفقة من سبقونا.
حين نودع الموتى
لكن الموتى لا يهمسون إلينا بأسرار الموت وحده. كما هو حال كل ما فقدناه، هم كنز من الصور والذكريات التي تذكرنا بما كنا عليه برفقتهم. يمنحوننا فرصة لتوسيع حبنا حتى لما لم يعد موجودًا، ويعلموننا أن نسامح ما كنا نظنه غير قابل للغفران، فليس هناك ما يستحق الضغينة في شيء لم يعد قادرًا على إيذائنا. في الحياة، علينا أن نحارب، لكن الموت ينبغي أن يكون مصالحة كاملة، صامتة كصمته.
ويجب أن نتركهم يمضون، رغم أنهم يظلون جزءً منا، ورغم أنهم أخذوا معهم جزءً منا. يجب أن نفهم من خلالهم ألم النهايات وجلالها. فمن خلال قبولهم كجزء من فقداننا المستمر، ندرك أن الحياة ليست سوى عملية تسليم بطيئة، نمنح خلالها ذواتنا قطعة بعد أخرى، حتى لا يبقى شيء نقدمه. حين نودع الموتى، فإننا نودع أنفسنا شيئًا فشيئًا. فلنفعل ذلك برفق، بلمسة من الحنان.
ورغم الغياب، يظل العطر عالقًا في الهواء، والضحكات تهمس في أذن الذكرى، وكأن الراحلين يصرون على البقاء بيننا بطريقة لا ندركها. فالموت يأخذ الجسد، لكنه يعجز عن أن يمحو الأثر، عن أن يقتلع الجذور التي امتدت في أعماق أرواحنا. سنحزن، سنبكي، وسنشتاق، لكننا في النهاية سنحملهم معنا في كل نبضة، في كل همسة، في كل لحظة تأمل صامتة. فبعض الرحيل ليس فناءً، بل ولادة جديدة في ذاكرة الحب الذي لا يرحل.