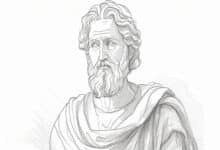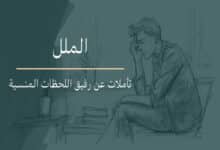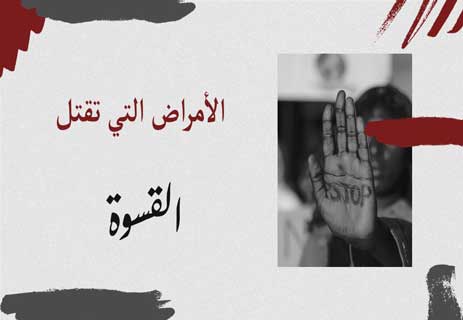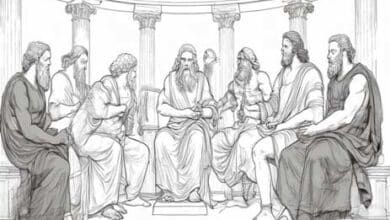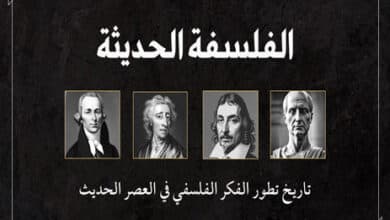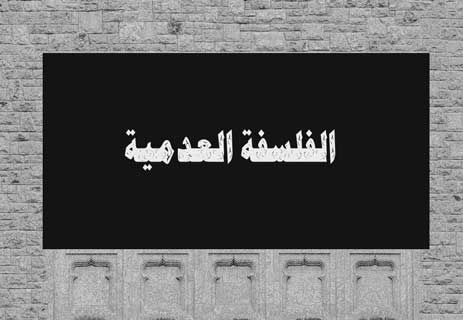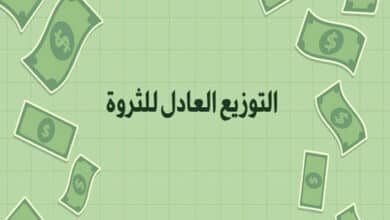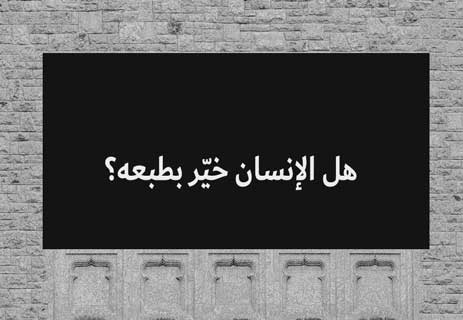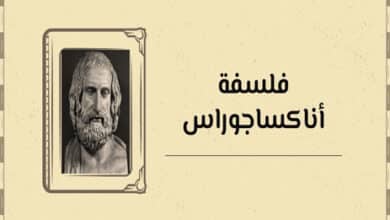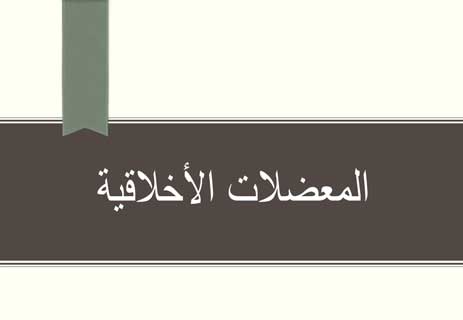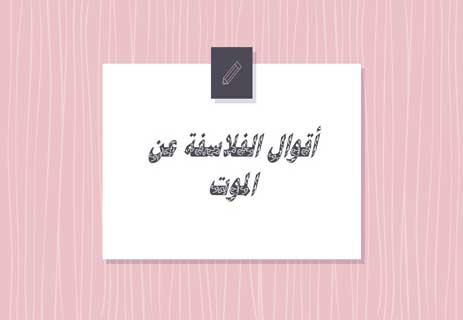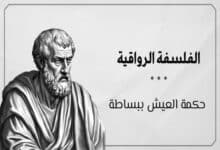هل الحياة عادلة؟ الحقيقة التي لا نحب سماعها
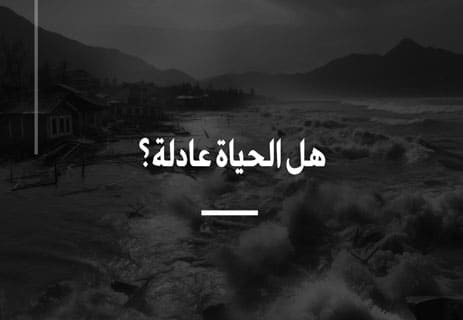
سعى البشر منذ القدم إلى فهم العدالة في هذا العالم: لماذا يكافأ البعض ويعاقب آخرون؟ وهل تنصفنا الحياة فعلًا وفقًا لأعمالنا؟ من الكارما إلى القوانين النفسية الحديثة، تتكرر الفكرة بأن الخير يعود بالخير، والشر ينقلب على صاحبه. لكن هل حقًا يعمل العالم بهذه الطريقة؟ هل الحياة عادلة فعلًا؟ في هذا المقال، نستعرض كيف يُشكل هذا الاعتقاد وعينا، ولماذا، رغم شعبيته، يعدّ وهمًا خطيرًا..
عدالة الحياة
ينتصر الأخيار، ويخسر الأشرار.. عاجلًا أم آجلًا، لكن في النهاية، يحصد كل شخص ما يزرع، ويحصل كل فرد على ما يستحق. تدعم مذاهب مختلفة هذه الفكرة. على سبيل المثال، تخبرنا الكارما أننا نتلقى ما نستحق وفقًا لسلوكنا تجاه الآخرين، بينما يؤكد “قانون الجذب” أننا نغير الواقع بأفكارنا، سواء للأفضل أو للأسوأ. أما باولو كويلو، فيؤكد أنه عندما ترغب بشيء بصدق، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك في الحصول عليه. أو كما تقول الجدات: “الله يعاقب بلا حجارة ولا عصي”.
تعد العديد من الأديان بالمكافآت والعقوبات، ولكن في الحياة الآخرة. على أية حال، الفكرة هي: ما يحدث لك من خير أو شر يعتمد بالكامل عليك. أو على الأقل، هكذا نود أن يكون العالم. لكن هل هو كذلك؟ لا، ليس كذلك. الحقيقة أننا جميعًا واقعون تحت تأثير انحياز معرفي، وهو خطأ نفسي شائع بين البشر، يُعرف باسم “مغالطة العالم العادل”. نحن نحب أن نعتقد أن الحياة عادلة جوهريًا، وأن ما يحدث للآخرين هو بالضبط ما يستحقونه. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد يمنحنا شعورًا بالراحة.
عندما نرى شخصًا يعاني، فإننا نفترض أنه استحق ذلك لأنه “فعل شيئًا”، أو “أثار الأمر”، أو “كان يبحث عن المتاعب”. يمنحنا هذا شعورًا بالأمان: إذا تصرفنا بشكل صحيح، فلن يحدث لنا مثل ذلك. كما يسمح لنا بالنظر إلى حظنا الجيد والتفكير بأننا كسبناه بفضل كوننا أكثر صلاحًا أو اجتهادًا أو ذكاءً من الآخرين. وأخيرًا، في عالم مليء بالعنف والظلم والاستغلال والشر، يمنحنا هذا الاعتقاد الأمل في أن الشر سيعاقب في يوم ما، والخير سيكافأ، سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى.
خذ على سبيل المثال مفهوم الكارما. على مدار حياتنا، سنفعل أمورًا جيدة وأخرى سيئة، وستحدث لنا أمور جيدة وأخرى سيئة. جزء كبير مما يحدث لنا سيكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لأفعالنا، لكن جزءً آخر سيكون مجرد مصادفة. إذا كنا نؤمن بالكارما، فإن انحيازنا للعالم العادل، إلى جانب انحيازات نفسية أخرى متأصلة فينا، سيجعلنا نؤكد صحة هذا الاعتقاد.
انحياز معرفي
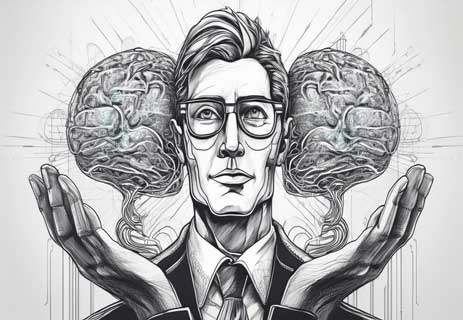
ميلنا لرؤية الأنماط في كل شيء، حتى عندما لا تكون موجودة، سيجعلنا نعتقد أن الخير الذي يحدث لنا هو نتيجة مباشرة للخير الذي فعلناه، حتى لو لم يكن هناك أي صلة واضحة بين الحدثين أو كانا متباعدين زمنيًا. على سبيل المثال، مساعدة شخص محتاج ثم العثور على مجموعة من الأوراق النقدية في الشارع بعد بضعة أسابيع ليس بينهما أي علاقة سببية. انحياز التأكيد لدينا ورغبتنا في تعميم تجاربنا الشخصية والاعتقاد بأنها قانون كوني سيجعلاننا نركز على اللحظات التي بدا فيها أن الحياة تنصف، ونتجاهل العدد الكبير من المرات التي لم يحدث فيها شيء على الإطلاق.
هذا لا ينفي وجود أسباب ونتائج، أو أن اتخاذ قرارات جيدة يؤدي عمومًا إلى نتائج إيجابية. إذا وضعت يدي في النار، سأحترق. إذا تبنينا عادات صحية، فمن المرجح أن نتمتع بصحة جيدة وحياة طويلة. ومع ذلك، يبقى الحظ عاملًا متغيرًا. قد يحدث شيء خارج عن إرادتنا يفسد خططنا: ربما نرث جينات سيئة أو نقع ضحايا لحادث غير متوقع. وفي نهاية المطاف، قد يجعلنا الحظ نرى شخصًا لم يعتنِ بنفسه جيدًا يعيش حياة أطول وأفضل منا. ما أريد قوله هو أن الكثير في الحياة عشوائي تمامًا ولا يعتمد على استحقاقاتنا أو أخطائنا.
نميل أيضًا إلى الخلط بين الحكمة والأخلاق. يمكن أن تؤدي التصرفات المتهورة (كمضايقة كلب، أو تناول الطعام غير الصحي، أو التجول في أحياء خطرة) إلى عواقب سلبية، بينما تجنبها يقلل من المخاطر. لكن هذا لا يعني أن الشخص يستحق، من الناحية الأخلاقية، أن يحدث له مكروه لمجرد أنه ارتكب خطأً أو اتخذ قرارًا سيئًا. على سبيل المثال، قد ينسى شخص ما قفل سيارته، ثم يكتشف لاحقًا أن كل شيء بداخلها قد سُرق. نعم، هناك علاقة سببية بين الحدثين، ولكن هل يمكننا القول إنه كان “يستحق” أن يفقد أغراضه؟
العدالة مفهوم أخلاقي

العدالة مفهوم أخلاقي، والأخلاق هي اختراع بشري بالكامل. فهي موجودة فقط في أذهان البشر وفي علاقاتهم مع بعضهم البعض. لكنها ليست جزءً أصيلًا من الطبيعة أو الحياة أو الكون، بل تعتمد بالكامل على ما نعتبره نحن عادلًا، وفقًا لنزعاتنا الفطرية التي تتشكل بناءً على الثقافة التي نشأنا فيها.
الأسباب والنتائج التي أشرنا إليها تحدث في الفيزياء (مثل الكرة التي ترتد عن الحائط) أو البيولوجيا (مثل العلاقة بين العادات والصحة). كما يمكن أن تحدث في المجال الاجتماعي والنفسي، حيث توجد الأخلاق. فإذا أسأنا معاملة شخص ما، فقد يسعى هو أو أحباؤه أو حتى طرف خارجي إلى معاقبتنا. وإذا كنا معروفين بعدم الأمانة، فقد يرفضنا مجتمعنا اجتماعيًا. لكن في الوقت ذاته، قد يحدث أن الضحية لا تمتلك القوة للدفاع عن نفسها، ولا تجد من يساعدها، فيظل الجاني طليقًا دون عقاب. وقد يكون الشخص المخادع محاطًا بالإعجاب والدعم من مجتمعه، بدلًا من أن يُنبذ. العدالة تعتمد كليًا على امتلاك البشر المعرفة والإرادة والقدرة على تحقيقها.
مبررات مريحة
لهذا، من العبث القول أن هناك قوة ما ستُسبب المرض لشخص شرير، أو ستجعل سيارة شخص صالح تعمل بسلاسة. من الصعب دحض الاعتقادات المتعلقة بالعدالة الجوهرية في العالم. يمكننا الإشارة إلى آلاف الأشخاص الذين يعانون أو عانوا من أهوال لا يمكن تفسيرها (مثل ضحايا الكوارث الطبيعية أو الأنظمة الديكتاتورية القمعية). ويمكننا الإشارة إلى الطغاة والمجرمين الذين ماتوا وهم في قمة السلطة، مسترخين في أسرتهم، دون أن يدفعوا ثمن أفعالهم. يمكننا التأكيد مرارًا وتكرارًا على أنه لا يمكن تغيير الواقع الفيزيائي من خلال التفكير في تغييره فقط.. لا تقول فيزياء الكم إن الواقع يمكن تغييره بمجرد التفكير فيه؛ الأفكار ليست طاقة تنبعث من الجمجمة مثل موجات الميكروويف لتؤثر على العالم المادي؛ وباختصار، لا يوجد أي آلية قابلة للرصد يمكن من خلالها أن تكون للأفكار أو الرغبات تأثير على الواقع الفيزيائي.
لكن المدافعين عن هذه الأفكار دائمًا ما يقدمون تفسيرات ارتجالية، مبررات مريحة لا يمكن اختبارها بطبيعتها: ربما لم يرغب الشخص في تحقيق أهدافه بقوة كافية، أو ركّز أكثر على خوفه من الفشل، ولهذا لم ينجح. ربما سيدفع الطاغية ثمن جرائمه في الحياة الأخرى. وربما كانت ضحايا غزة أشخاصًا سيئين في حياتهن السابقة… وهكذا دواليك.
الحياة ليست عادلة

المشكلة في الاعتقاد بعدالة العالم ليست فقط أنه خاطئ ولا يمكن الدفاع عنه، بل إنه أيضًا خطير جدًا. أولًا، لأنه عندما نعهد بمهمة تحقيق العدالة إلى الكارما أو الكون أو آلهة العالم السفلي، فإننا نتخلى عن مسؤوليتنا في تصحيح الظلم في هذا العالم. في الواقع، نشأت العديد من هذه المعتقدات تحديدًا لتبرير أنظمة غير عادلة. الكارما، التي يراها بعض الساذجين كقمة الروحانية، وُلدت في الهند كمبرر لنظام الطبقات القاسي: لقد وُلدت في طبقة دنيا لأنك كنت شخصًا سيئًا في حياتك السابقة، لكن إذا كنت جيدًا الآن، فقد يكون لك حظ أوفر في حياتك القادمة. في ظل الملكيات المطلقة، قيل إن مشيئة الله هي أن يمتلك الملك كل السلطة، وأن يظل الفقير عبدًا، وإن كان الملك ظالمًا، فإن الله سيحاسبه بعد موته، لكن لا يحق للعبد أن يتمرد عليه.
الشعور بالتعاطف
ثانيًا، لأن هذا الاعتقاد يخدّر واحدة من أكثر الصفات إنسانية لدينا: القدرة على الشعور بالتعاطف. إذا رأينا شخصًا يعاني وقلنا: “لا بد أنه فعل شيئًا ليجلب ذلك على نفسه”، فإننا بذلك نرفض التعاطف معه. هذه هي الفكرة الكامنة وراء عبارات مثل: “لقد اغتصبوها لأنها استفزتهم”، أو “لقد قُتلوا لأنهم كانوا مثيري شغب”. حتى المشكلات الصحية تُفسَّر أحيانًا بهذه العقلية، مثل الادعاء بأن السرطان يصيب أولئك الذين لا يعبّرون عن مشاعرهم جيدًا: وكأن حتى المرضى بأقسى الأمراض هم وحدهم المسؤولون عن مصيرهم. يحمينا هذا الوهم النفسي من القلق، لأنه يجعلنا نعتقد أن تلك المصائب لن تحدث لنا، لأننا نفعل “ما ينبغي” ونتجنب “ما لا ينبغي”. لكن هذه الفكرة المريحة تجعلنا نهرب من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه من يحتاجون إلى المساعدة، وننتهي بإلقاء اللوم عليهم في معاناتهم.
الكون ليس عادلًا، لكنه أيضًا ليس ظالمًا. لا علاقة للكون بكل ما نعتقد به، لكن البشر يمكنهم أن يكونوا عادلين، ويمكنهم السعي لتحقيق العدالة، ويمكنهم محاربة الظلم. وحقيقة أن الكثير مما يحدث يعتمد على الحظ وقوى خارجة عن إرادتنا لا ينبغي أن تكون سببًا للاستسلام. عندما نتخلى عن هذا السعي، نصبح نحن من يتحول إلى البرودة واللامبالاة.
ليست كل أشكال تجلّي مغالطة “العالم العادل” واضحة تمامًا أو خرافية بوضوح. هناك شكل خفي منها، وهو الاعتقاد بأن المكافآت والعقوبات لا تُوزَّع وفقًا لقوى خارقة للطبيعة، بل وفقًا لقوانين متأصلة في طبيعة الأشياء. لكن هذا هو موضوع المقال التالي: هل التوزيع العادل للثروة مجرد وهم؟