
تتحكم الحكايات والأساطير القديمة في تصورتنا عن العدالة والثروة، لكن في عالم اليوم، يبدو أن العدالة التي طالما حلمنا بها قد تكون مجرد وهم. هل التوزيع العادل للثروة ممكن حقًا؟ هل الثروة حقًا تأتي نتيجة للموهبة والجهد الفردي؟ أم أن توزيعها لعبة عمياء تحكمها الصدفة والامتيازات الموروثة؟ وهل حقًا يُكافأ المجتهدون بالثروات التي يستحقونها، أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا أكبر في تحديد المصير الاقتصادي للأفراد؟ في هذا المقال، سنتناول تأثير المغالطات المعرفية، مثل مغالطة العالم العادل، وكيف أن هذه الأفكار قد تساهم في خلق صورة مشوهة للعدالة الاقتصادية في عالم مليء بالتفاوتات الاجتماعية..
الثروة والفضيلة
تقول أسطورة إغريقية قديمة، أن بلوتو، إله الثروة، كان يكافئ الرجال العادلين بالثراء. لكن زيوس، الذي نعرف جميعًا أنه كان وغدًا من الطراز الرفيع، لم يكن معجبًا بهذه الفكرة، فأرسل صاعقة أفقدت بلوتو بصره. منذ ذلك الحين، صار بلوتو يوزع ثرواته عشوائيًا، دون تمييز. وكالعديد من أساطير العصور القديمة، تحمل هذه القصة شيئًا من الحكمة: الاعتراف بأن الثروة لا تعتمد على الفضيلة.
ومع ذلك، فإن الفكرة السائدة اليوم هي أنه – على الأقل في المجتمعات الرأسمالية – يتم توزيع الثروة بطريقة عادلة بطبيعتها، بحيث يحصل عليها الموهوبون والمجتهدون والمساهمون في المجتمع. بينما يبقى الفقراء والفاشلون في أماكنهم لأنهم لا يعملون بجدٍ كافٍ أو لأنهم ببساطة يفتقرون إلى المهارات.
تحدثنا من قبل، عن عدالة الحياة، وهو انحياز معرفي يجعلنا نعتقد أن الحياة عادلة بطبيعتها، وأن كل شخص يحصل في النهاية على ما يستحقه. رأينا كيف أن هذه النزعة النفسية تمنحنا شعورًا بالراحة، لأنها تجعلنا نشعر بأننا نستحق ما نملك وتحمي عقولنا من القلق الناجم عن إدراك أننا قد نصبح ضحايا للظروف (لأننا نقوم بكل شيء بشكل صحيح). لكن في المقابل، تجعلنا نفقد التعاطف مع أولئك الأقل حظًا، لأننا نحكم عليهم بأنهم مسؤولون عن معاناتهم.
المغالطة الطبيعية
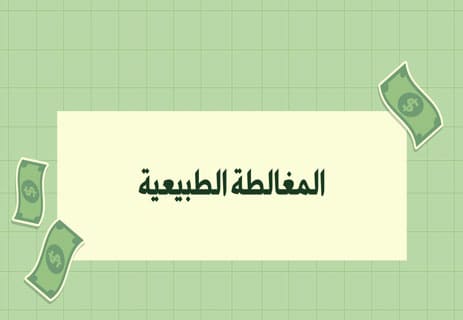
يتجلى هذا الانحياز في المعتقدات الخرافية التي تتراوح بين الحق الإلهي للملوك والكارما وقانون الجذب. كما يظهر أيضًا في الإيمان الأعمى بعدالة النظام الاجتماعي والاقتصادي الذي نعيش فيه: الرأسمالية القائمة على الجدارة. وهنا يختلط هذا الأمر مع انحياز معرفي آخر شائع جدًا: المغالطة الطبيعية، التي تفترض أن ما يحدث في الطبيعة هو بطبيعته جيد أو أخلاقي.
تصور الداروينية الاجتماعية تشابهًا بين البقاء للأصلح في الطبيعة ونجاح “الأفضل” في المجتمع. في الطبيعة، لا ينجو جميع الأفراد ليتكاثروا، بل فقط أولئك الذين يمتلكون السمات التي تجعلهم أكثر قدرة على البقاء. وفي المجتمع، إذا سمحنا بالتنافس الحر بين الأفراد كما هو الحال في الطبيعة، فسوف ينجح الأصلح، أي من يحصلون على الثروة والسلطة. وأي تدخل في هذا النظام يعني معارضة “قوانين الطبيعة”.
المشكلة هي أن نظرية داروين تصف كيف يعمل العالم، لكنها لا تقول كيف يجب أن يكون. لا يوجد شيء في الطبيعة يشير إلى أن ما يحدث بين الكائنات الحية في حالتها الطبيعية هو الشيء الصحيح أو الأخلاقي أو العادل. عندما يهزم أسد ذكر أسدًا آخر في قتال ويستولي على أرضه وإناثه، فإنه يقتل أشبال عدوه لضمان استمرار نسله. فهل هذا فعل أخلاقي أو غير أخلاقي؟ لا هذا ولا ذاك.. إنه ببساطة الطريقة التي تسير بها الأمور في قانون الغاب.
وهم التوزيع العادل
هل التوزيع العادل للثروة مجرد وهم؟ بالطبع، مجرد وجود المغالطتين الطبيعية والعالم العادل لا يعني تلقائيًا أن النظام الاقتصادي القائم على المنافسة الحرة لا يضمن التوزيع العادل للثروة.. لكن هل يمكننا إثبات أن مقولة “الفقراء فقراء لأنهم أقل شأنًا، والأغنياء حصلوا بالضبط على ما يستحقون” مجرد خرافة؟
نعم، يمكننا ذلك..
يقال إن النجاح الاقتصادي يعتمد على جهود الفرد نفسه. وأنه ليس ذنبك أن تولد فقيرًا، لكنه خطؤك إذا بقيت فقيرًا عند بلوغك سن الرشد. في الواقع، تلعب الظروف الأولية التي يولد فيها الشخص والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها دورًا كبيرًا في مستقبله الاقتصادي. على سبيل المثال، تُظهر الدراسات الإحصائية أن هناك ارتباطًا قويًا بين دخل الوالدين وما سيكسبه الأبناء عند دخولهم سوق العمل. وترتبط الحركية الاجتماعية بمستويات عدم المساواة الموجودة في المجتمع. وهذا يعني أنه في المجتمعات التي تعاني من معدلات عالية من التفاوت الاجتماعي (مثل مصر)، تقل احتمالية أن يصل الفرد إلى وضع اقتصادي أفضل (أو أسوأ) من والديه[1].
وليس فقط أن معظم الثروات الكبيرة اليوم موروثة، بل إن إمكانية تحقيق الازدهار الاقتصادي يعتمد إلى حد كبير على الظروف الاجتماعية التي لا يتحكم فيها الفرد، مثل معدلات الأمان، واستقرار الحكومة، ومستويات التعليم، والقوة الشرائية للمواطنين، ووجود بنية تحتية مثل الطرق السريعة، وغيرها[2].
الحظ والامتياز

عند مراجعة ملفات رواد الأعمال الناجحين، نجد أن الغالبية العظمى منهم بدأوا من مواقع امتياز: لم يولدوا فقط مع إمكانية الوصول إلى رأس المال العائلي الذي يسمح لهم بالقيام باستثمارات أولية، بل لديهم أيضًا شبكات دعم تساعدهم في حال فشلت مشاريعهم الأولى. وفي ظل هذه الظروف، يصبح الإبداع وتحمل المخاطر أسهل بكثير؛ فـ”ملاحقة الأحلام” ليست فرصة متاحة للجميع[3].
والأمر الأكثر لفتًا للنظر هو أن بعض السمات النفسية المرتبطة بالنجاح في ريادة الأعمال، مثل الميل إلى المخاطرة وعدم الامتثال للقواعد، ترتبط أيضًا بارتفاع احتمالية ارتكاب بعض الجرائم البسيطة (مثل المقامرة، وتعاطي المخدرات، أو حتى السرقة). لكن، بالنسبة لشاب من عائلة ميسورة، فإن احتمال أن تؤدي هذه السلوكيات إلى عواقب تؤثر على مستقبله ضئيل جدًا. في حين أن شابًا من طبقة فقيرة قد يواجه الطرد من المدرسة أو حتى اتهامات قانونية. بعبارة أخرى، يمكن لنفس السمات النفسية أن تجعل شابًا مديرًا تنفيذيًا لشركة ناجحة أو ينتهي به الأمر في السجن.. وذلك حسب ما إذا كان قد وُلد ثريًا أو فقيرًا[4].
أسطورة الفرص المتساوية
من الناحية المثالية، يُفترض أن يكون التعليم المحرك الرئيسي للحراك الاجتماعي، أليس كذلك؟ ولكن الواقع يكشف أن الظروف الأولية تصنع فروقًا كبيرة في النتائج النهائية. من الواضح أن المال يتيح الوصول إلى مدارس أفضل، بالإضافة إلى أنشطة لا منهجية تُحفّز القدرات المعرفية وتوسع آفاق المعرفة لدى الأطفال. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالإحصائيات تُظهر أن أبناء الأثرياء الذين يحققون نتائج سيئة في المدرسة وأبناء الفقراء الذين يحققون نتائج ممتازة نادرًا ما يغيرون موقعهم في الهرم الاجتماعي. فالأطفال الأثرياء، حتى لو رسبوا أو طُردوا من المدرسة، لا يحتاجون إلى شهادة دراسية لوراثة ثروة العائلة أو إدارة أعمال والدهم. في المقابل، الأطفال الفقراء، حتى لو حصلوا على درجات ممتازة، يميلون إلى البقاء في الأحياء الفقيرة، بعيدًا عن الفرص التي قد تساعدهم على التقدم.
وإذا افترضنا، لمجرد النقاش، أن رجل الأعمال يستحق أن يكسب أكثر من الموظف لأن مساهماته في المجتمع أكبر، فمن المشروع التساؤل عما إذا كان من العدل أن تكون الفجوة في الثروة بهذا الحجم الهائل في عالمنا اليوم. حيث يمتلك 62 فردًا ثروة تعادل ما يمتلكه نصف سكان العالم الأكثر فقرًا[5]. وحتى لو سلمنا بأن الأشخاص ذوي المواهب الاستثنائية يستحقون ثروات استثنائية، فماذا عن الأخلاقيات التي تبرر وجود أشخاص يعيشون في فقر مدقع وكأنهم بلا قيمة؟
الموهبة وحدها لا تكفي

إن نجاح الشركات الكبرى لا يأتي فقط من جهد وموهبة مؤسسيها. ولا من تقديم أفضل المنتجات أو الخدمات بأفضل الأسعار، بل من استغلال ظروف لم يخلقوها بأنفسهم، مثل الإعانات والتنازلات الحكومية التي يحصلون عليها عبر الضغط السياسي، وغياب المنافسة، وتأثير الشبكة، ووجود عمالة رخيصة، والقدرة على استغلال مواهب الموظفين الذين تصبح إبداعاتهم ملكية فكرية لأصحاب الشركة.. أو ببساطة بسبب وجود موارد طبيعية ثمينة تنتظر من يَستخرجها. ربما كان ستيف جوبز يستحق أن يكون ثريًا، لكنه لم يكن يستحق أن يكون فاحش الثراء[6].
لو كان العالم قائمًا على الجدارة بشكل مثالي، لكان كل شخص يكافأ بما يتناسب مع أدائه، أليس كذلك؟ كما هو الحال في المدرسة، حيث يحصل من يبذل الجهد الأكبر على علامة 10. ومن يكون أداؤه جيدًا يحصل على 8. ومن يعمل بمستوى متوسط يحصل على 7، وهكذا. لكن في الواقع، لا توجد فرص متساوية للجميع، بل هناك العديد من الحالات التي ينتهي فيها الأمر بأن “الرابح يأخذ كل شيء”. يمكننا التفكير في منح التفوق الأكاديمي كمثال. لنفترض أن هناك 10 منح دراسية متاحة لأفضل 10 طلاب في مدرسة ثانوية حكومية. ماذا عن الطالب رقم 11؟ لنفترض أن معدله 90% من معدل الأول على الدفعة، فهل يحصل على منحة تعادل 90% من قيمة منحة الأول؟ لا، ببساطة لا يحصل على أي شيء.
تحقيق الثراء
أتذكر مقولة في فيلم “السعي وراء السعادة” بطولة ويل سميث: “إذا كنت تريد، فستحقق ذلك”. في هذه القصة المستوحاة من الواقع، يمر بطل الفيلم بالكثير من المعاناة بحثًا عن وظيفة تُمكّنه من إعالة ابنه الصغير. ولكي يحصل على منصب مرموق في شركة كبيرة، كان عليه أن يعمل مجانًا لفترة من الزمن، متنافسًا مع مرشحين آخرين حتى يثبت أنه الأجدر بالوظيفة. وفي النهاية، ينجح بالطبع. لكن، إذا تجاوزنا حقيقة أن الشركة استغلت عمل جميع المرشحين دون أجر لعدة أشهر، دعونا نسأل: ماذا لو كان بطل القصة هو ثاني أفضل مرشح؟ هل كان سيحصل على مكافأة تتناسب مع مستواه؟ لا، كان سيعود إلى الشارع مجددًا.
إن الذين يحتفلون بنجاح الأشخاص الذين تمكنوا من تحقيق الثراء رغم أصولهم المتواضعة، يتجاهلون عدة أمور. عندما ننظر في قصص هؤلاء الأشخاص، لا نجد فقط دليلًا على موهبتهم وإصرارهم، بل أيضًا العديد من ضربات الحظ (التواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب)، ودعمًا حصلوا عليه من أشخاص آخرين (وجود معارف في الأماكن المناسبة يساعد كثيرًا). هذه قصص استثنائية عن أشخاص استثنائيين، واستخدامها كـ”دليل” على أن أي شخص يمكنه أن يصبح ثريًا يشبه القول إن أي راعي ماشية سيصبح جنكيز خان.
إن افتراض أن الحياة ستكون عادلة إذا تُركت لقوى السوق الغامضة ليس سوى خرافة علمانية. نسخة حديثة وأقل تطورًا من الاعتقاد البالي بالكارما أو بالحق الإلهي للملوك.. وكما هو الحال مع هذه المعتقدات، فإنها تبرير غير مستدام لنظام اجتماعي يحكم على الغالبية العظمى بالإحباط. بينما يخلق طبقة متميزة تعتقد أنها متفوقة على الآخرين.
العدالة مشروع إنساني

هل تتذكرون كيف أن الوقوع في مغالطة “العالم العادل” يقلل من التعاطف مع الأقل حظًا؟ (هناك المزيد عن هذا الموضوع في قائمة المصادر)[7]. هذا يتجلى بأقصى درجة في حالة الأغنياء، الذين اعتادوا على الاعتقاد بأنهم يستحقون ثروتهم لأنهم أفضل من أولئك الذين يملكون أقل. في الواقع، تشير الدراسات النفسية إلى أن الأغنياء يميلون إلى إظهار سلوكيات نرجسية وأن يكونوا أكثر استغلالًا واستعلاءً تجاه الآخرين. كما أنهم أقل سخاءً وتعاطفًا، وأكثر لا مبالاة باحتياجات الآخرين، بسبب اعتقادهم بأن الآخرين أقل قيمة[8].
لا يتعلق الأمر بإنكار أن الموهبة والجهد يلعبان دورًا في تحقيق النجاح الاقتصادي في مجتمع رأسمالي. فمن المؤكد أن العمل الجاد أفضل من عدم العمل. ربما يتفق معظم الناس على أن الشخص الذي يؤدي عملًا يتطلب مسؤوليات كبيرة ومهارات خاصة يستحق مكافأة كبيرة. لكن السؤال هو: إلى أي مدى يجب أن تكون هذه المكافأة كبيرة؟ في عالم أصبح فيه من الأسهل الاستغناء عن المصرفيين مقارنةً بجامعي القمامة، كيف نحدد مقدار المساهمة الحقيقية لكل شخص في المجتمع؟ هذا في الواقع إعادة تقديم للصيغة القديمة: “العدالة تعني أن يحصل كل شخص على ما يستحقه”. ولكن كيف نحدد ما يستحقه كل فرد؟ لأن ما فعلناه حتى الآن هو التفكير بالعكس: نرى من يحصل على المزيد، ثم نبحث عن مبررات عقلانية لشرح سبب استحقاقه لذلك.
لعبة الحياة
ما أريد الإشارة إليه هو أن هناك عوامل أخرى، خارجة عن الإرادة الفردية والفضيلة، تلعب دورًا حاسمًا في لعبة الحياة. ولا يعني ذلك أننا لا يجب أن نسعى إلى تحقيق الجدارة. ولكن يجب أن نكون مدركين أنه مهما حاولنا، لا يمكن أن تكون الجدارة مثالية، بل تتطلب مراقبة مستمرة وتأملًا، وجهودًا واعية ومتعمدة، وتجارب وأخطاء لجعلها تعمل، دون الاعتماد على ثقة عمياء في مبدأ ميتافيزيقي يفترض أن العدالة ستتحقق تلقائيًا إذا تُركت الأمور لـ”قوانين الطبيعة”..
في النهاية، حين ننزع الأقنعة عن الأساطير التي نحتمي بها، ندرك أن العدالة ليست هبة تلقائية من الطبيعة ولا نتيجة حتمية لقوانين السوق. إنها مشروع إنساني هش، لا يقوم إلا بإرادتنا الواعية، ومسؤوليتنا الجماعية في بناء مجتمع أكثر إنصافًا. أن نؤمن بالجدارة لا يعني أن نغض الطرف عن أثر الحظ والظروف؛ بل يعني أن نسعى لإصلاح الخلل، وأن نرفض تبرير الفجائع الاجتماعية بوهم الاستحقاق الطبيعي. لأن العالم لا يصبح أكثر عدلًا من تلقاء نفسه، بل بأيدينا وحدها.
المصادر
[1] The Economics of Inequality, Poverty, and Discrimination in the 21st Century …
[2] You Might Have Earned It, But Don’t Forget That Your Wealth Came from Society.
[3] Entrepreneurs don’t have a special gene for risk—they come from families with money.
[4] Entrepreneurship: The Ultimate White Privilege?
[5] Oxfam says wealth of richest 1% equal to other 99%
[6] Extreme Inequality Is Not Driven by Merit, but by Rent-Seeking and Luck.
[7] Believing that life is fair might make you a terrible person.
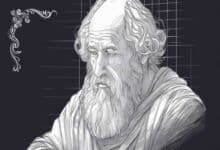


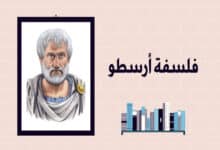

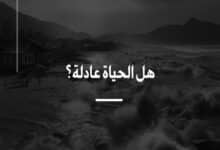
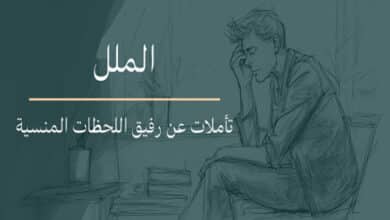
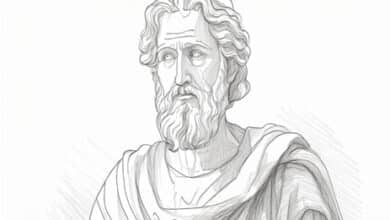
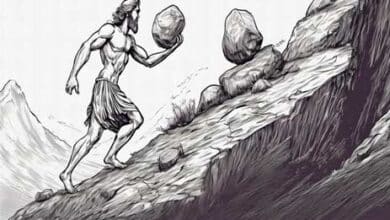
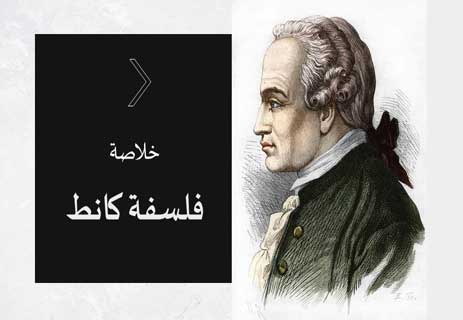
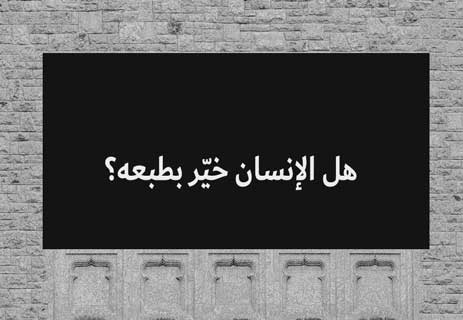


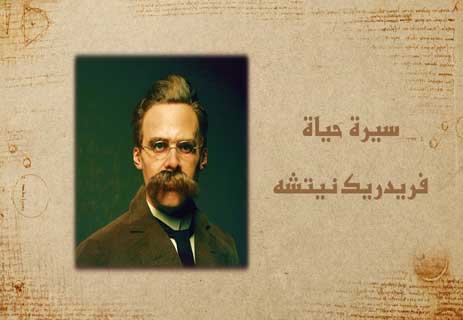


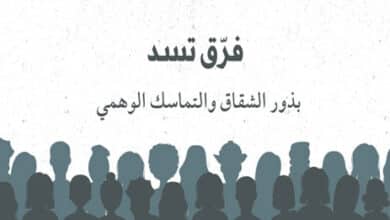
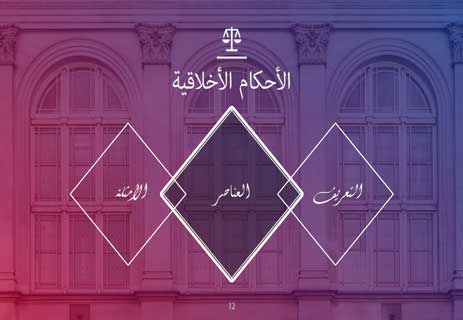



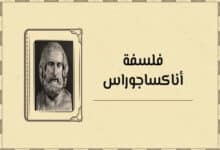
مقال تحليلي ماتع يلفت النظر لحقائق قد تكون غائبة عن البعض.
شكرًا عزيزي على هذه الإشادة