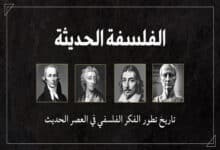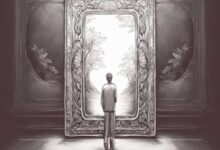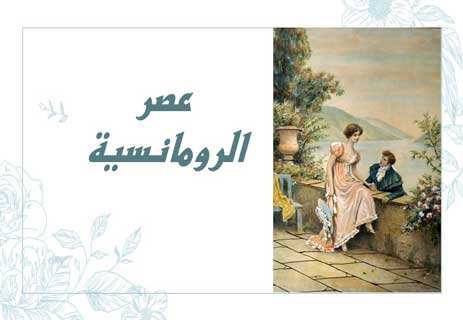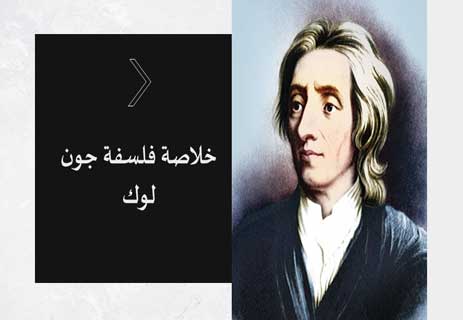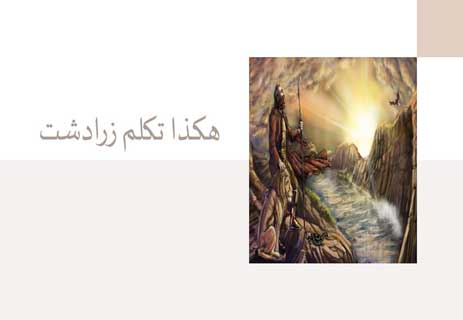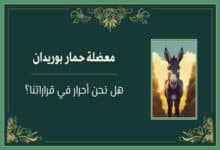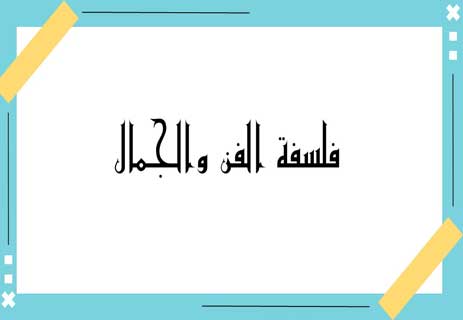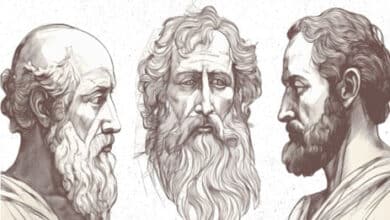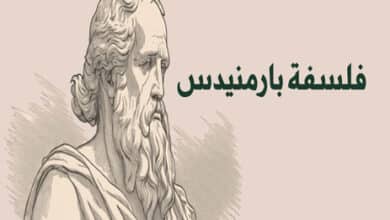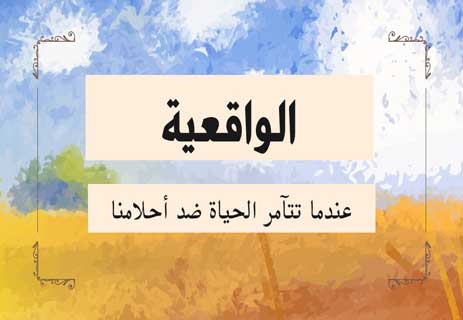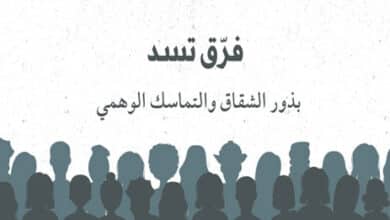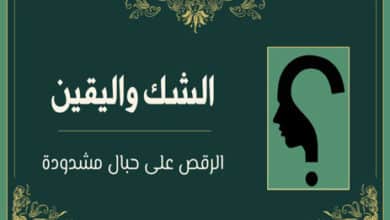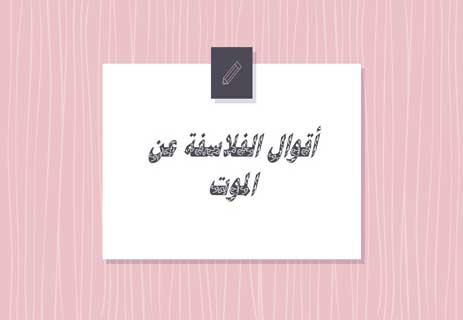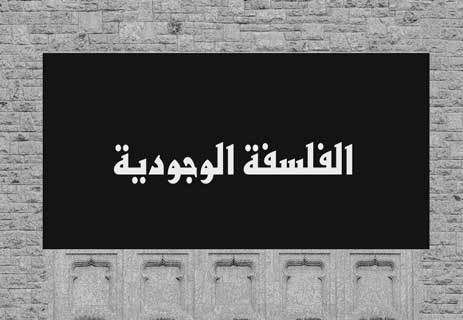الفلسفة الحديثة: تاريخ تطور الفكر الفلسفي في العصر الحديث
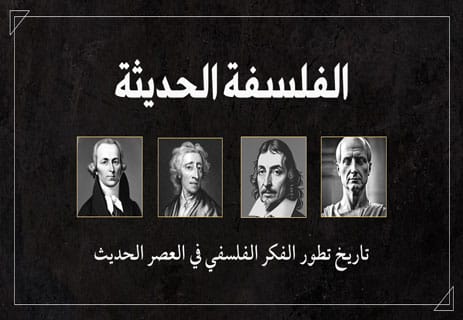
عندما نغوص في أعماق تاريخ الفلسفة الحديثة، نغرق في بحر من الأفكار التي تحرك العقول وتلهمها، وتفتح أمامنا أبواباً من التأمل والتساؤل عن الكون، والإنسان، والمجتمع. لم تكن الفلسفة الحديثة مجرد سلسلة من الأفكار المجردة أو تأملات فلسفية معزولة، بل كانت بمثابة نبوءة لزمن جديد؛ زمان يرتكز على العقل، ويبحث عن الحقيقة عبر التجربة والعقلانية. من ديكارت الذي نادى بـ “أنا أفكر، إذاً أنا موجود”، إلى كانط الذي تحدى حدود المعرفة، وصولاً إلى روسو الذي أعاد تشكيل المفاهيم السياسية والاجتماعية، كانت الفلسفة الحديثة بمثابة الضوء الذي أضاء مسارات جديدة في التفكير الإنساني، معترفًا بقدرة العقل على إحداث التغيير في مجمل وجوه الحياة.
فكر عصر النهضة
كانت مركزية الإله هي التي طبعت التفكير الفلسفي في العصور الوسطى، وفي مواجهة هذه المركزية تميزت الحداثة بكونها حقبة تتمحور حول الإنسان، حيث احتل البعد الإنساني مركز الصدارة في التفكير الفلسفي. تحقق هذا الانتقال من التمركز اللاهوتي في العصور الوسطى إلى التمركز حول الإنسان في الحداثة خلال عصر النهضة. أصبح الإنسان في هذا العصر صانع مصيره، بفضل عبقريته وجهوده، ويمكن رؤية هذا المثال بوضوح في شخصية ليوناردو دافنشي. استطاع الإنسان في عصر النهضة السيطرة على الطبيعة وإعادة تشكيل النظام الاجتماعي. وفي حين كانت الفلسفة في العصور الوسطى مقيدة بمبدأ السلطة، أعاد عصر النهضة قراءة أعمال الكُتّاب الكلاسيكيين بموضوعية جديدة، مما أدى إلى إحياء الفكر وتحقيق نهضة فكرية واسعة بفضل الترجمات الجديدة والنصوص التي برزت بعد سقوط القسطنطينية عام 1453.
لكن لم تكن كل الأمور إيجابية؛ فقد اختفت يقينية النظرة الكونية في العصور الوسطى، وأصبح الإنسان صانع مصيره، إلا أن هذا المصير الذي كان مغلقًا ومضمونًا في السابق، بات الآن مفتوحًا على احتمالات غير متوقعة. هذا الاضطراب الفكري الناجم عن انهيار عقلية العصور الوسطى التقليدية وظهور الإنسان كمركز للكون أدى إلى عودة السحر كنظام فكري. كان السحرة في عصر النهضة مثل باراسيلسوس هم الأسلاف المباشرون للعلما. حيث سعوا لفهم الطبيعة عبر العلاقات والقوانين، لكن افتقار السحر إلى الدقة والكفاءة بالإضافة إلى غياب الأساس الرياضي دفع الفلسفة الحديثة إلى هجر هذا الفكر الباطني الغامض لصالح العلم.
مركزية الإنسان
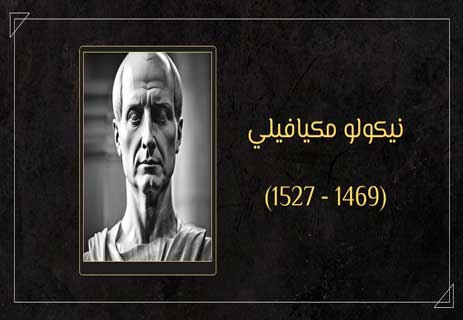
إذا كان الإنسان مركز الكون الطبيعي في عصر النهضة، فإنه أصبح أيضًا مركز الكون السياسي. وفي القرن السادس عشر، عندما بدأ نفوذ الكنيسة بالتراجع بفعل الإصلاح البروتستانتي، ظهرت أفكار سياسية يوتوبية، حيث اعتقد أن الإنسان يمكنه باستخدام عقله إعادة تشكيل العلاقات السياسية بشكل مستقل، مستندًا فقط إلى العقل. هذه الأفكار الطوباوية النهضوية كانت النواة الثورية التي ألهمت الثورات السياسية الكبرى في العصر الحديث، من الثورة الفرنسية إلى الثورات الاشتراكية في القرن العشرين.
وفي السياق ذاته، يمكننا أن نشير إلى الفكر السياسي الواقعي الذي أسسه الفيلسوف الفلورنسي نيكولو مكيافيلي (1469 – 1527) من خلال عمله الشهير “الأمير“. يعتقد مكيافيلي أن الهدف الأساسي للحاكم هو الحفاظ على السلطة، بغض النظر عن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يظهر هذا العمل بوضوح أن الفرد أصبح محور التفكير السياسي.. وهو تحول لم يكن موجودًا في الفلسفة القديمة أو الفكر المسيحي في العصور الوسطى.
الثورة العلمية
شهدت أوروبا ما يُعرف بالثورة العلمية بين القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولم تغير الإمكانيات التقنية للبشرية فحسب، بل غيّرت أيضًا طريقة رؤية العالم والواقع إلى حد كبير.. كما قوضت بشكل نهائي أسس مركزية الإله في العصور الوسطى. وعلى الرغم من وجود جذور مبكرة للمنهج العلمي في فلسفة ويليام أوكام، إلا أن عصر النهضة شهد تبلور فكرة الطبيعة الرياضية على أيدي المؤلفين الفيثاغوريين الجدد. لكن تنسب البداية الحقيقية للثورة العلمية إلى نيكولاس كوبرنيكوس (1473 – 1543) الذي نُشر بعد وفاته كتابه “حول دوران الأجرام السماوية”. حيث استبدل فيه الكون الذي مركزه الأرض بكون مركزه الشمس (مركزية الشمس). ثم جاء جاليليو جاليلي (1564 – 1642) بعد سنوات كأحد أبرز المدافعين عن نظام كوبرنيكوس، مما جعله الأب الروحي للمنهج العلمي.
تأسيس المنهج العلمي: جاليليو جاليلي
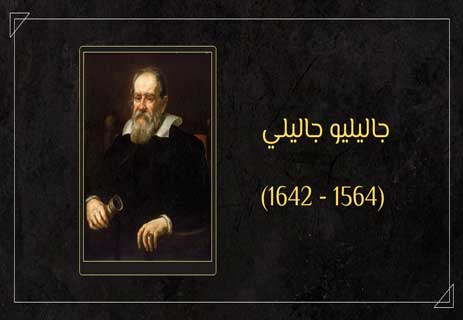
اكتشف جاليليو عن طريق بنائه للعدسات والأجهزة الفلكية كالأسطرلاب، البقع الشمسية وحلقات زحل وأقمار المشتري. جعلته هذه الاكتشافات يدرك التناقضات في نموذج مركزية الأرض الذي قدمه بطليموس، حيث يخضع الكون فوق القمري (supralunar) للتغير، وليست كل الأجرام السماوية تدور حول الشمس. هذه البيانات التجريبية، بالإضافة إلى بساطة نظام مركزية الشمس (النظام الكوبرنيكي)، دفعته إلى تبني هذا النموذج.
أسس جاليليو من خلال أبحاثه في علم الفلك والفيزياء المنهج العلمي لدراسة الطبيعة، والذي نسميه اليوم العلم. كانت الطبيعة بالنسبة لجاليليو تتحدث بلغة رياضية.. ومن لا يفهم هذه اللغة لن يتمكن من إدراك أي شيء مما يحدث في العالم. وكان يرى أنه ينبغي علينا تجنب الفرضيات الميتافيزيقية واللجوء إلى الطبيعة ذاتها لاستكشاف أسرارها.
ميزة أخرى في الفلسفة الحديثة هي التمييز بين الخبرة والتجربة. التجربة هي التقاط الحواس لشيء حقيقي، لكن كل التجارب تتم معالجتها في أذهاننا من خلال معتقدات شخصية أو عقائد مفروضة، لذلك يمكن أن تكون الخبرة مفيدة في المجال العملي، ولكنها ليست مفيدة لبناء العلم. ومن ناحية أخرى، فإن التجربة العلمية تحصر إطار التحليل في بعض السمات القابلة للقياس للظاهرة قيد الدراسة وتتجاهل العناصر الأخرى غير القابلة للحساب.
وأخيرًا، هناك سمة أخرى ذات صلة للطريقة الجديدة وهي أهمية العقل في المعرفة العلمية. ففي مواجهة المذاهب التجريبية المتطرفة التي اعتبرت أن التجربة هي كل شيء في المعرفة العلمية، اقترح جاليليو أنه على الرغم من أنه لا يمكن تأكيد القانون الطبيعي إلا من خلال التجربة، فإن بناء القانون يسبق الخبرة. يقوم العالم بتطوير فرضية تتناقض بعد ذلك مع الواقع لأن الخبرة وحدها لا تكفي للقيام بالعلم. باختصار، حاول إيجاد نقطة وسط بين التجريبية الراديكالية وعقلانية ديكارت.
أهمية إنشاء هذه الطريقة هائلة. فمن ناحية، جعلت أكثر الرجال استنارة في أوروبا يبدأون في التحدث والتحقيق معًا في النظام الطبيعي للكون، مما سمح بالمعرفة السريعة والثورية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا الأسلوب قوض أسس كل دوغمائية أو مبدأ السلطة.. وقد ساهم هذا الابتعاد عن السلطة في تشكيل العقلية الغربية حتى يومنا هذا. وبعد سنوات من وفاة جاليليو انطلق العلم والتكنولوجيا إلى أبعد من ذلك. حيث وحد إسحاق نيوتن (1643 – 1727) مع نظريته في الجاذبية حركة مدار الكواكب مع حركة الأجسام على الأرض، فدمر بذلك أي بقايا من الكون البطلمي..
العقلانية القارية: ديكارت
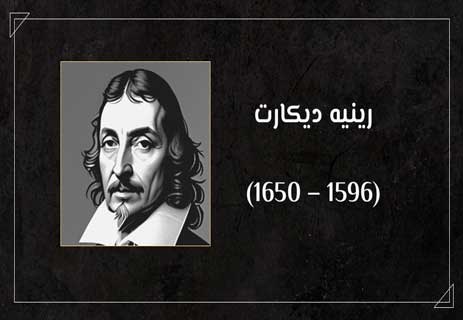
العقلانية القارية هي حركة فلسفية ظهرت في القرن السابع عشر، أي في خضم الحداثة. وسُمّيت “قارية” لأنها ازدهرت في القارة الأوروبية، في حين كان التيار التجريبي يهيمن فقط في الجزر البريطانية، حيث تعتبر التجربة الوسيلة الأساسية لفهم الواقع.
من الصعب تعريف العقلانية بدقة نظرًا لوجود عدد كبير من الفلاسفة الذين يمكن اعتبارهم عقلانيين. ومع ذلك هناك سمات بارزة تميز العقلانية، ومن أبرزها الأهمية الكبيرة التي يوليها العقلاني للعقل كأداة للوصول إلى المعرفة مقارنة بالتجربة الحسية أو سلطة المؤسسات الدينية أو الثقافية. كما يعتقد العقلانيون بوجود أفكار أو وظائف فطرية في أذهان جميع البشر تنشط عند حدوث التجربة ولكنها مستقلة عنها. وأخيرًا، تمثل الرياضيات بالنسبة للعقلانيين نموذجًا للمعرفة بفضل دقتها ومنهجيتها النظامية.
ديكارت ومنهجه الفلسفي
بنى الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت (1596 – 1650) منهجه الفلسفي اعتمادًا على الرياضيات بهدف الوصول إلى معرفة يقينية لا شك فيها. لاحظ ديكارت، مثل غيره من معاصريه، أن العلوم الطبيعية مثل الرياضيات والفيزياء تتقدم باستمرار عبر الزمن، بينما تفتقر الفلسفة إلى نظام أو منهج يسمح لها بتكوين معرفة متماسكة ومتفق عليها بين الفلاسفة. ولهذا السبب، سعى ديكارت إلى بناء منهج فلسفي مشابه لنظام الهندسة الإقليدية، يبدأ من بديهيات واضحة ولا يمكن الشك فيها.. ومن ثم يُبنى عليها كل نظام المعرفة الفلسفي بشكل منهجي.
“أنا أفكر، إذن أنا موجود”
رفض ديكارت كل ما يمكن الشك فيه، متجاوزًا التجربة الحسية. واكتشف أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن الشك فيه هو وجود الذات المفكرة أثناء التفكير. ومن هنا جاءت عبارته الشهيرة “أنا أفكر إذن أنا موجود”. بناءً على هذا اليقين الأول، استنتج ديكارت أن “أنا” كائن محدود، لأن الكائن غير المحدود لن يشك أبدًا في وجوده. وبالتالي، فإن فكرة الكائن اللامحدود (الله) موجودة في عقلي كفكرة فطرية، لكنها لا يمكن أن تأتي من ذاتي المحدودة أو من أي كائن محدود آخر. لذا، فإن هذه الفكرة الفطرية مصدرها كائن غير محدود، أي الله.
يثبت ديكارت وجود الله.. لكن الله في فلسفته الحديثة ليس الإله الذي يستمد وجوده من الإيمان أو سلطة الكنيسة، بل هو نتيجة استدلال فلسفي خالص، خالٍ من أي تأثير إيماني. لا يظهر الله في النظام الديكارتي إلا بعد أن يتأكد الفيلسوف من وجود الذات المفكرة. تعكس هذه النظرة طبيعة العقلانية الحديثة التي تقبل بفكرة “إله الفلاسفة”.. لكنها ترفض أي تخمينات دينية أو إيمانية معقدة. وبذلك، يعود العقل المحض لمواجهة ألغاز العالم، كما كان الحال في العصور القديمة.
التجريبية: لوك وهيوم

ظهرت التجريبية في الجزر البريطانية في مواجهة العقلانية القارية. تكمن المشكلة الرئيسية التي تعالجها هذه الحركة في كيفية حدوث المعرفة.. فالأطروحة التجريبية هي أن المعرفة الحقيقية تأتي بشكل أساسي وحصري من التجربة. وعلى المستوى الأخلاقي والسياسي والديني، تبنى التجريبيون مواقف متسامحة بعيدة عن أي تعصب.. وهو موقف يتسق مع الشك الذي أظهره هؤلاء المؤلفون تجاه أي نوع من التفسير الذي لا يعتمد على التجربة.
وفي حين كان حجر الزاوية في نظام ديكارت هي “أنا أفكر”، فإن التجريبية تعتبر هذا الموضوع ثانوي، مجرد معالج للبيانات الحسية، الذي يربط ويحلل ويعيد بناء التجربة الحسية، والتي هي الأهم حقًا.
كما أنكر التجريبيون وجود أفكار فطرية. حيث يولد الإنسان كصفحة بيضاء دون أفكار مسبقة؛ والأحاسيس فقط هي التي تملأ عقل الكائن البشري. بالنسبة للعقلانية الديكارتية، فإن فكرة الله الفطرية تضمن واقع العالم الخارجي.. أما بالنسبة للتجريبيين، فإن واقع العالم الخارجي هو مسألة إيمان، يمكننا افتراض وجوده لأنه يولد أحاسيس لدينا، لكن المعرفة الحقيقية هي تلك الأحاسيس، وليس العالم الخارجي الذي لا يمكن الوصول إليه دون الخبرة.
فلسفة جون لوك
كان جون لوك (1632 – 1704) يرى أننا نعرف بفضل الأفكار التي لدينا في العقل، ولكن من أين تأتي هذه الأفكار؟ لا يمكن أن تأتي إلا من التجربة، سواء كانت خارجية (حس) أو داخلية (تأمل). يمكن أن تكون الأفكار بسيطة أو معقدة.. فالأفكار البسيطة تنشأ مباشرة من الإحساس أو التأمل، وهي “ذرات الإدراك” (فكرة اللون الأحمر، فكرة الحصان، إلخ).. أما الأفكار المعقدة فهي تنشأ من دمج الأفكار البسيطة (فكرة الجمال، فكرة الفضيلة الأخلاقية، إلخ).
كان لوك وفيًا في انتقاده للتعصب، ومدافعًا قويًا عن التسامح بين جميع الأديان. حيث إن البشر يمتلكون حقوقًا طبيعية غير قابلة للتصرف من بينها حرية الضمير. ولا يجوز للدولة أن تتدخل في البحث عن سعادة الأفراد، طالما أن هذا البحث لا يتعارض مع السلام الاجتماعي.
فلسفة ديفيد هيوم
يقدم ديفيد هيوم (1711 – 1776) بعد لوك تأملات وفية للمبادئ التجريبية كما يظهر من انتقاده للسببية أو الجوهر. يعتقد هيوم أن علاقة السبب والنتيجة هي علاقة تقدمها عقولنا في الواقع. وأن حدوث شيء بعد آخر لا يعني بالضرورة أنه نتيجة له. على سبيل المثال، إذا قربنا يدنا من لهب نشعر بالحرارة، فنستنتج أن اللهب هو الذي يولد الحرارة. لكن وفقًا لهيوم، هذا شيء نضيفه بشكل ذاتي إلى إدراكنا للشيء. حيث إن علاقة السبب والنتيجة (اللهب – الحرارة) لا تظهر في إدراك اللهب أو الحرارة، بل في عقولنا.
يحدث نفس الأمر مع فكرة المادة. ما هي فكرة التفاحة أو التفاحة نفسها؟ إذا أزلنا الخصائص مثل اللون والطعم والشكل المادي، فلا يبقى شيء من التفاحة، لأن جوهر التفاحة غير موجود ولكنه بمثابة تعميم لعقولنا.. فقط التفاح الملموس له وجود حقيقي، أما مفهوم التفاحة فلا وجود له.
الفلسفة الحديثة في عصر التنوير
يُعرف عصر التنوير بأنه الفترة التاريخية الممتدة بين أواخر القرن السابع عشر وأواخر القرن الثامن عشر (الثورة الفرنسية) والتي تميزت بثقة عميقة في إمكانية تحسين الحالة البشرية من خلال العقل. لم يكن التنوير حركة متجانسة بل كان بيئة ثقافية ساعدت في إحداث تغييرات جذرية في التنظيم السياسي لأوروبا وفي العقلية الغربية.
انطلق المفكرون في عصر التنوير من النقد اللاذع لأي سلطة لا تعتمد على العقل البشري نفسه. وقد ساد بين المثقفين الأوروبيين عدم الثقة في الكنيسة والدولة الاستبدادية. كان ينظر إلى السلطة المطلقة، وافتقار المواطنين للحرية، والخرافات الدينية على أنها عوائق أمام تقدم البشرية. وكانت المعرفة العلمية تعتبر أداة أساسية لتطوير الإنسان.
كما يؤكد الفكر التنويري في الفلسفة الحديثة على أهمية التعليم لتكوين مواطنين قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية. ويجب أن يبدأ هذا التعليم من الطفولة. ويستلهم من المعاملة الإنسانية للطفل وتطوير العقل الطبيعي الذي يشترك فيه جميع البشر. هذه العقلانية المشتركة بين الجميع جعلت المفكرين التنويريين أول من طرح فكرة أن جميع البشر، لمجرد كونهم بشرًا، لديهم حقوق لا يمكن مناقشتها والتي لا يمكن سلبها إلا استثنائيًا من قبل المجتمع، ودائمًا بعد محاكمة قانونية.
المثالية المتعالية: إيمانويل كانط
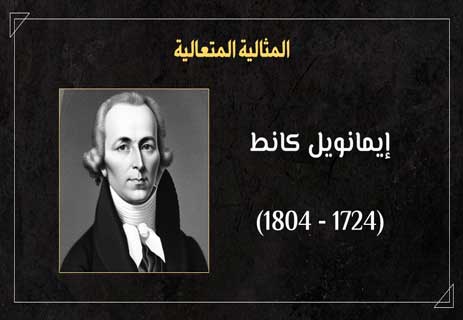
ظهرت المثالية المتعالية لإيمانويل كانط (1724 – 1804) في عصر التنوير.. وهي الفلسفة الحديثة التي تتماشى مع المركزية التي يحظى بها الإنسان في الفكر التنويري. وفقًا لكانط، كان العديد من المفكرين حتى ذلك الحين يرتكبون خطأً أساسيًا: يعتبر الإنسان مرآة تلتقط الواقع كعنصر سلبي بحت. وفي مواجهة هذه العقلية، يقدم كانط نظريته التي يرى فيها أن الإنسان هو قطب نشط في فعل المعرفة. والإنسان عند معرفته بالعالم يعالج تلك البيانات من خلال هياكل خاصة به. حيث يتم إنتاج المعرفة بفضل هذه الهياكل التي تقوم بفلترة وإعادة بناء البيانات التي تتلقاها. الشخص عند المعرفة، يُكوّن ويخلق المعايير التي تجعل المعرفة ممكنة.
ومن ناحية أخرى، لن يتمكن الإنسان أبدًا من معرفة “الشيء في ذاته”. ولن نتمكن من معرفة ما هو العالم بذاته بشكل مستقل عن عقولنا. وبهذه الطريقة يمنح كانط الإنسان دورًا بارزًا في فعل المعرفة لم يكن له من قبل. ولكن في المقابل، يجب على هذا الإنسان أن يتقبل حدود عقله التي ستقتصر على العالم المادي والرياضي. وأي معرفة ميتافيزيقية أو لاهوتية تحاول تجاوز التجربة فهي تتجاوز حدود العقل الطبيعية. ويعد النموذج المثالي للمعرفة اليقينية التي تتطور ضمن حدودنا هو العلم النيوتوني.
الفلسفة السياسية: جان جاك روسو
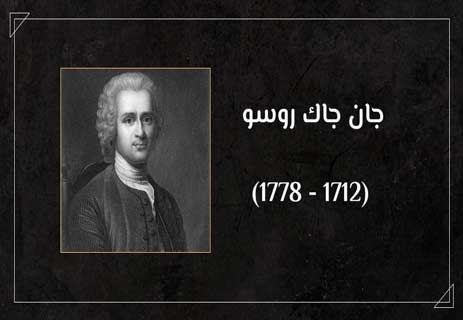
مفكر آخر من مفكري التنوير والفلسفة الحديثة هو جان جاك روسو (1712 – 1778)، الذي يعتبره العديد من المفكرين الأب المؤسس للديمقراطية الحديثة. لقد حاول هذا المفكر في كتابه “العقد الاجتماعي” تحديد الطريقة التي نشأ بها المجتمع السياسي لكي يستنتج ما هو النظام السياسي الطبيعي والعادل.
وفقًا لروسو، وصل المجتمع البشري إلى مرحلة في تطوره الاجتماعي تم فيها تأسيس الملكية بين الناس. وعندما حدث هذا، أصبح من الضروري إيجاد طريقة للقرار والمداولات العامة، وإلا فإن الصراع من أجل الحصول على الممتلكات وحمايتها سيؤدي إلى حرب الجميع ضد الجميع. ولمنع ذلك، يتم إنشاء العقد الاجتماعي الذي يشترك فيه جميع أفراد الشعب على قدم المساواة.. إذ من يمكنه التنازل عن الحرية والمساواة الطبيعية مقابل الخضوع وعدم المساواة السياسية؟ ولا تستمد السيادة إلا من هذا الميثاق – العقد – ومن ينتهكه ويحاول قمع أعضاء المجتمع من خلال نفي السيادة عنهم هو لص، سواء كان يسمى ملكًا أو إمبراطورًا أو سلطانًا. يمارس السيادة جميع أعضاء المجتمع كجزء لا غنى عنه من الكل. وإذا لم تتحقق هذه السيادة المشتركة، فلا توجد هيئة سياسية حقيقية، بل مجرد تجمع للأشخاص.
وفي ختام هذا الرحلة الفكرية عبر تاريخ الفلسفة الحديثة، نجد أن هذه الفلسفات لم تكن مجرد أفكار تقتصر على صفحات الكتب أو صفحات الزمن، بل هي نبضات حية لا تزال تشعرنا بالحاجة المستمرة للتفكير والتساؤل. من خلال معركة الفلاسفة مع العقل، والحرية، والمعرفة، أرسوا أسسًا لفكر مستمر في تطوره، فظل تأثيرهم يتسع مع مرور الأجيال. وعلى الرغم من مرور قرون، تبقى الفلسفة الحديثة مرآة تعكس آمال الإنسان في فهم نفسه والعالم من حوله. وتبقى الدعوة إلى التنوير، والتحرر من القيود الفكرية، راسخة في ذاكرة العصور، دافعة بنا نحو المستقبل بكل ما يحمله من تساؤلات ورغبة في البحث عن الحقيقة.
مراجع
|
1. Author: Horace Craig Longwell, (01/01/1928), Medieval and Modern Philosophy, www.jstor.org, Retrieved: 03/30/2025. |
|
2. Author: Chris Wright, (01/01/2020), The history of early modern philosophy, www.researchgate.net, Retrieved: 03/30/2025. |
|
3. Author: Richard Falckenberg, (08/15/2013), History of Modern Philosophy, www.books.google.com, Retrieved: 03/30/2025. |